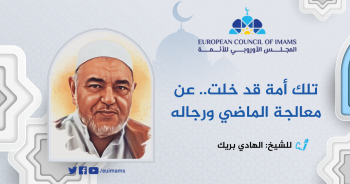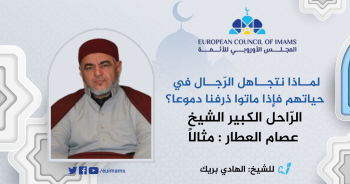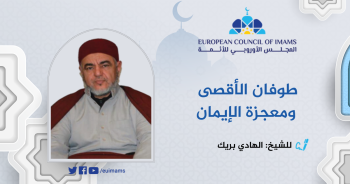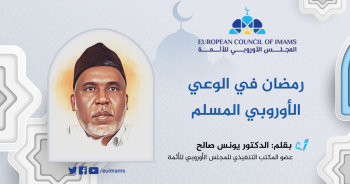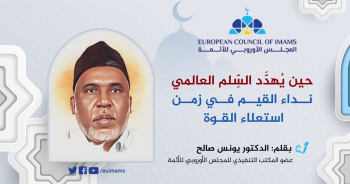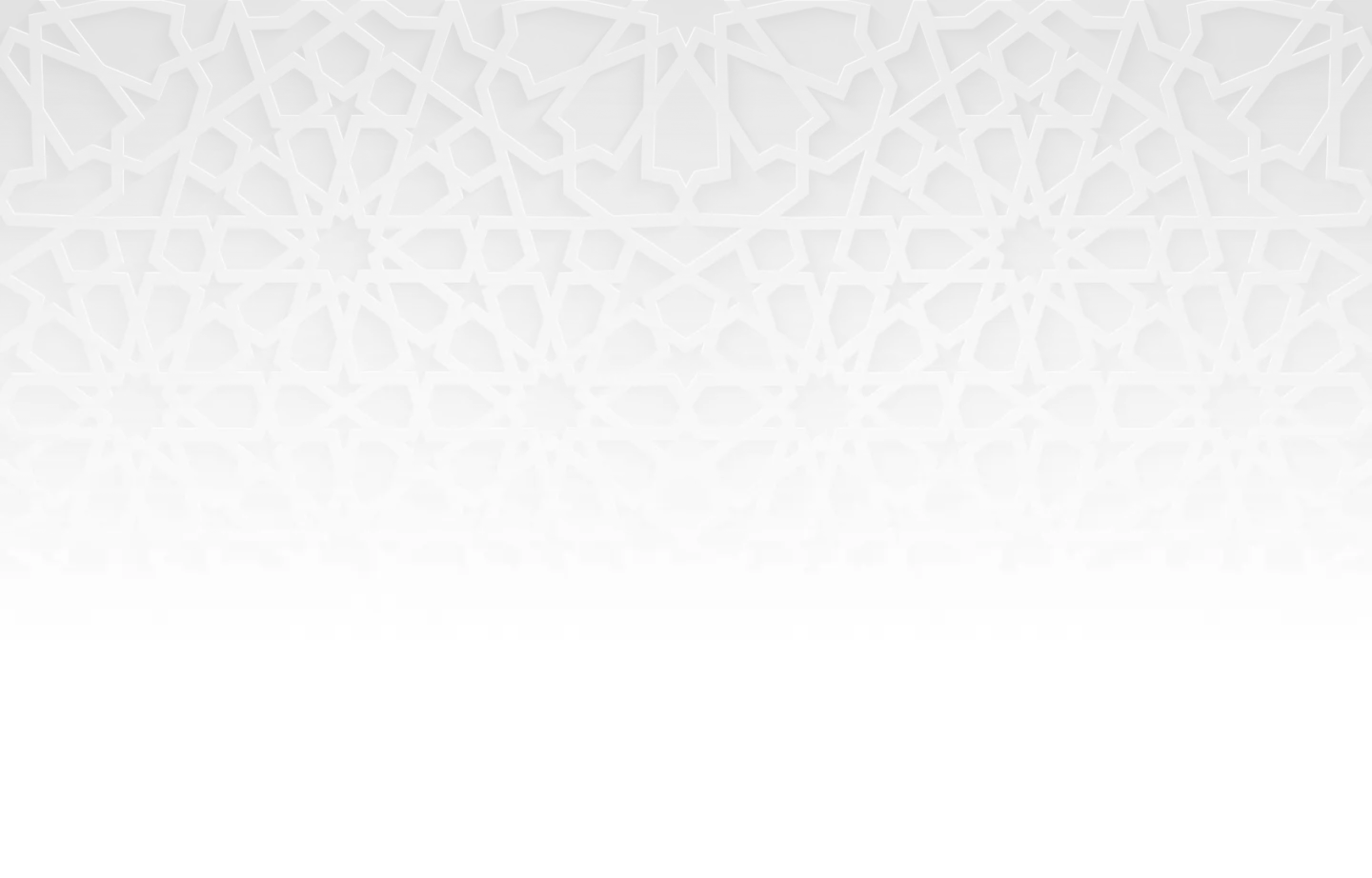
المقاصدية: سبيل استقامة أم تمييع؟

قال لي صديق منذ أيام قليلات ـ معاتبًا ـ إنّ سبيل المقاصدية انتهى بالتدين العام للناس إلى ضرب من الميوعة والتحلّل من بعض التكاليف الشرعية، وهو في ذلك ينحو باللائمة على سالكيه من الأئمة المعتبرين. ولم تكن هي المرة الأولى التي أستمع فيها إلى مثل ذلك، بل هو شعور يكاد يكون عامًا عند من يقف على ضفاف العلم، هواه مع القراءة الجامعة (موضوعيًا لا موضعيًا، ومقاصديًا لا وسائليًا، وجماعًا لا تجزئة، واجتهادًا لا تقليدًا)، ولكنّ عقله لم يتشبّع بالمنهج الجامع في كل جوانبه تشبعًا يجعله يطمئنّ نفسيًا إليه.
ولكنّ التخوّف مفهوم، والمحذور واقع، إذ سلك المنحى المقاصدي من دون لزوم شروطه ومنهجه العام شراذم كثيرة من المتعلمنين، ومن البسطاء والسذّج كذلك، فجعلوا من التدين إمعية لا تردّ يد لامس، كما قال عليه السلام في شأن بغيّ.
ولكن ما ينبغي لنا أن يغيب عنّا ما أسمّيه الإطار العقليّ الشامل للتديّن، الذي من وعاه أَمِنَ نفسًا وعقلًا، ومن جهله كأنّما ولج قصرًا مشيدًا وهو مغمض العينين، فلا يفتحهما عدا وهو فيه.
الدين له ظاهر وباطن، أو خارج وداخل، تراثنا كلّه تقريبًا انغمس في باطنه وجزئياته وداخله، وليس ذلك قصورًا فيه ولا في أهله، ولكن كان ذلك لسبب واحد، وهو أنهم عندما دوّنوا ذلك كانوا يخاطبون أجيالهم التي تعيش تحت سقف إسلاميّ واحد، حتى وهو يحوي منكرات هنا وهناك.
من جهل ذلك، فقد حكم على نفسه إمّا بعدم فهم الإسلام فهمًا صحيحًا، أو بتدنيس التراث وأهله.
كلّ شيء طَرَأَ مطلقًا البتة إذا أُخرج من سياقه أصبح لا معنى له، حتى كتاب الله نفسه. فمن قرأ: ﴿فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ﴾ ثمّ ركع أو ختم تلاوته وذهب في سبيل حاله إلى شأن آخر، فقد اجتزأ وابتسر وأساء، بسبب أنه أخرج الآية من سياقها.
أكثر المتدينين اليوم يهملون السياق الخارجيّ للإسلام، أي الصورة العامة الجامعة لقصر الإسلام المشيد، ومنظره الجامع الذي يراه الرائي من الخارج. يهملون ذلك جهلًا، فإذا كانوا داخل ذلك القصر المشيد لا يغنيهم شيء أنهم يتأوّلون فروعه وجزئياته من دون علم سابق وصحيح بذلك الإطار الخارجيّ.
ولذلك تجد الكتاب العزيز ـ الذي هو الحاكم الأوّل والموجّه الأوّل على كلّ شيء، بما في ذلك السنّة ذاتها ـ لا يهتمّ كلّ اهتمام سوى بذلك الإطار العامّ، الذي فيه الأصول والمعاقد والكليات والمقاصد، أي التضاريس الجامعة الكلية العامة التي هي بمثابة الدليل القوليّ ـ قبل العمليّ ـ لكلّ رحلة. وهو ما نسميه اليوم: Navigationsystem.
المقاصدية مكوّن واحد ضمن لوحة عامّة
ألا ما أصدق العرب إذ قالوا: "الإنسان عدوّ ما جهل"، وعندما قالوا كذلك: "الحكم على الشيء فرع عن تصوره".
ظللنا لسنوات طويلات ـ أنا ومئات أو ربما آلاف من أقراني في السبعينات، وحتى في بعض سني الثمانينات الأولى ـ نظنّ جهلًا أنّ المقاصدية هي في مقابل النصية. وكان ذلك لسببين:
أوّلهما: أنه في تلك الأيام صعدت أسهم اليسار الإسلاميّ، الذي تأثّر هو نفسه بنوع ما ونسبة ما بالتيار الاشتراكيّ. وليس التأثّر عيبًا، عدا عندما يفقد بوصلته فيخلط بين ما يُستورد وبين ما لا يُستورد. ظلّ ذلك التّيار يدندن حول قالة هي عموده، وهي: أن النصّ في الدين، حتى عندما يكون قطعيًا محكمًا، يُؤخّر لتتقدم المصلحة أو الواقع أو العقل.
في تلك الأيام، لم نكن نميز بين نصّ وآخر. وتسلّلوا إلى الشريعة لإبطال بعض أحكامها القطعية ـ ولا يهمّني إن كان ذلك بسوء نية أو بحسنها، فذلك موكول إليه وحده سبحانه ـ باسم المقاصدية، وإعمال العلّة، ورعاية المتغيرات، وغير ذلك مما هو في أصله حقّ. ولكنّ الحقّ ـ كلّ حقّ ـ عندما لا يكون في مكانه الأنسب، فهو باطل بالانقلاب والثمرة.
ثمّ ساق الله إلينا من أرشدنا وعلّمنا أنّ المقاصدية ليست في مقابل النصّ مطلقًا البتة ـ كيف وهما صنوان كالليل والنهار، والروح والجسد ـ ولكنّ المقاصدية تكون في مقابل الوسائلية.
المقصد في كلّ شيء مطلقًا ثابت راسخ لا يتغيّر.
ولكنّ الوسيلة إلى كلّ مقصد ـ عدا ما كانت وسائله موقوفة، من مثل أن الصلاة وسيلة إلى الراحة النفسية، والزكاة وسيلة إلى التزكية، وغير ذلك مما هو محصور حصرًا في حقلي الاعتقاد والعبادة بمعناها الخاصّ ـ تتغيّر أبدًا.
وما أسفت لشيء أسفي أنّي كنت في تلك العقود المنصرمة أقرأ وأستمع إلى قيادات في التدين والتوجيه، يقولون ويكتبون أن المقاصدية في مقابل النصّ. وهو ضلال مبين، عندما يكون النصّ مما سُمّي مفسّرًا محكمًا قطعيًا كلّ قطعية.
ولج ذلك العلمانيون كلّ ولوج، وأثّروا، وانطلت حيلتهم على ملايين مملينة من المسلمين والمسلمات، سيما في البلاد التي غشيتها رياح العلمنة.
ذلك إذًا هو الضابط الأوّل للمقاصدية: أنها ليست في مقابل النص عندما يكون علاجه من لدن المؤمن والمؤمنة هو فقط: "سمعنا وأطعنا".
ولكنّ المقاصدية تكون دومًا ـ ودون أي استثناء ـ في مقابل الوسائلية التي تتغيّر.
الأمثلة أكثر من الكثرة، وربما كتبت في هذا مرّات، وقد يسعفني هذا المقال ـ الذي لا أريد له طولًا ـ أن أُذكّر بأمثلة قصيرة صغيرة.
الضابط الثاني الذي يجعل من المقاصدية جزءًا من المشهد العقلي العام الذي يتيح للإنسان فهمًا صحيحًا وتنزيلًا أصحّ، هو أن المقاصدية لها منزلتان:
-
المنزلة الأولى: أنها تأتي تالية للنص وفاعلة فيه أفعالًا كثيرة، منها التعميق، ومنها بيان أوجهه، ومنها إحالته إلى التعليل، وغير ذلك.
تلك المنزلة تجعلها لا تتقدم النص، حتى من حيث الاهتمام. ولذلك لا يمكن أن يتعلم طالب العلم الجادّ المثابر ـ وليس الهازل ـ المقاصدية عدا من بعد تعلّمه الأصولية، أي تقديم أصول الفقه على أصول المقاصد.
ومعلوم أن كلا العلمين كانا قبل الشاطبي في سفر واحد، ومنهج واحد، ومسار واحد.
فمن تعلّم المقاصدية قبل الأصولية ـ أي علة النص قبل النص نفسه ـ فكأنّما قدّم الحاجة الروحية على الحاجة المادية.
أين تقطن الروح بدون مأوى جسميّ؟ خلق الله الجسد في بطن الأم، ثم في زمن ما نفخ فيه من روحه سبحانه. وليس نفخ من روحه ثم خلق الجنين. -
المنزلة الثانية: أن المقاصدية خادم لمطلب الفهم الصحيح. وهي عضو في ذلك الطاقم الخدميّ. ككلّ عضو، لها مكانها ومنزلتها ومرتبتها التي لا تتقدّمها ولا تتأخرها. يعني: وحدها لا تُغني شيئًا، بل تُضلّ.
وخير ما قيل فيها: أنها روح الحكم الذي لا يقوم بدونها.
لم أقرأ علاقة بين المقاصدية والنصية أجلى من تلك: "النص جسم، والمقصد روح"؛
فلو انفصل جسم عن روحه فقد مات، ولو انفصلت روح عن جسدها فالمآل ذاته.
إمّا صنوان يعتلجان معًا ليصنعا إنسانًا، أو موت.
أملي لو يستوعب المتدين هذا:
أعود إلى ما أسميه الإطار الخارجي للإسلام.
لست أدري هل هذا مفهوم أم لا؟ ربما يكون كذلك بسبب عدم الكتابة فيه إلا قليلًا.
ولكنّ هذا مبثوث في الكتاب العزيز كلّ بثّ.
من ذلك ما قاله عليه السلام ـ مثلًا ـ لمعاذ في آخر الحديث:
"رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد"
ذلك تصوير هيكلي للإسلام، رسم فني بديع، حقّه اليوم تطوير بالوسائل المعاصرة ليتعمق الفهم ويتصحح.
ومن ذلك ـ مثال آخر ـ قوله عليه السلام في حديث الدارقطني:
"إن الله فرض فرائض فلا تضيّعوها، وحدّ حدودًا فلا تعتدوها، وحرّم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمةً بكم غير نسيان، فلا تسألوا عنها."
هذا كذلك هيكل للإسلام.
والمهمّ هنا هو ترتيب تلك الأرباع الأربعة ترتيبها الذي به وردت: تقديم الحدود على المحرّمات.
ومن ذلك كذلك أن الحدود بالمعنى القرآني ـ وليس العرفي ـ أي: الأسرة وما يتعلق بها، كما ورد ذلك في خمسة مواضع منه.
وأن السكوت عمّا يُعد أسئلة العطّالين والبطّالين والمتسكعين هو رُبع رابع ركين من تلك الواجبات.
أجل، السكوت في محل السكوت عبادة، مثل الحزن في محل الحزن، والفرح في محل الفرح.
وقبل ذلك ـ ربما ـ حديث جبريل المعروف ومنازله الثلاث:
الإيمان، والإسلام، والإحسان.
أما من القرآن الكريم، فهو كثير، لأنه متمحض بالمقام الأول لذلك.
من ذلك ما يرد بما يريده الله، مثل:
﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ﴾
﴿وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا﴾
﴿يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ﴾
وغير ذلك مما ورد بلفظ الإرادة. لأن ما أراده الله واقع لا محالة.
فمن حادّه فيما يريد، فلم يعصه فحسب، بل حادّه كما يحادّه أعداؤه.
الإرادة فوق الأمر وقبله.
ومن ذا كان عقابه للشذوذ أكبر من عقابه للفاحشة مرّات ومرّات.
لأن الشذوذ فسوق عن منهجه وشرعته ووضعه، ولكن الفاحشة فسوق عن شرعه.
ولذلك أخبرنا أنه ما أنزل علينا إلا شرعة ومنهاجًا معًا:
﴿لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾
عصيان المنهاج شذوذ فكري، فلا يُغفر، ولكن عصيان الشرعية شهوة قد تُغفر، سيما للتائب.
ومن ذلك في الكتاب العزيز ما ورد بفعل الأمر، من مثل:
﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾
﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ﴾
﴿قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ﴾
لو يسر الله لي تحرير كتاب في المقاصد ـ فقد جهزت أمه ـ فهي أن مقاصد الله منّا، بالمقام الأول، هي ما أراده وما أمر به فحسب.
تلك هي أمّ المقاصد الإسلامية العظمى، وإليها يعود كل مقصد فرعي، وعليها يُبنى كل مقصد كلي.
الإطار الخارجي للإسلام هو ما تحدّث به غير مسلم،
وليس ما تحدّث به مسلم، إلا في حالات خاصة، من مثل سؤال منه مثلًا، أو في حالات تنكّب المنهج الأرشد للدعوة والحوار.
ها هو الله نفسه سبحانه، وعلى امتداد عقد ونيف، لم يُخاطب مشركي مكة ـ ولو بكلمة واحدة ـ عن تفاصيل الإسلام.
هل قصّر في ذلك؟
هل تنكّب منهجًا؟
لا. ولكن نحن ورثنا تراثًا دوّن لغيرنا، فظننا أنه لنا.
علينا تدوين تراثنا لعصرنا، والإفادة من تراث غيرنا، حتى من تراث غير المسلمين، فكيف بتراث أسلافنا؟
كيف ثبت الصحابة في المدينة بين قتيل وجريح، وفقيد وأسير، وفقير ويتيم، وأرملة وثكلى، وخائف وجائع وظمآن؟
بسبب ما أُشبعوا في مكة من القيم القرآنية الأولى، التي شكّلت: المنهج، والكليات، والمعاقد، والمقاصد، والأسس، والمباني، والجذور.
ولا يصلح آخر هذه الأمة ـ كما قال الإمام مالك ـ إلا بما صلح به أولها:
أي تقديم ما حقه التقديم، وتأخير ما حقه التأخير، وتكبير ما حقه التكبير، وتصغير ما حقه التصغير، والجمع بين العيني والكفائي، والمتعيّن وغير المتعيّن، والعاجل والآجل.
لكم آمل أن يستوعب كلّ متديّن قبل توبة وتدين هذا:
أ ـ الإسلام دين جامع
على معنى أنّ وسطيته ليست سجادًا أحمر مفروشًا لكل متديّن جديد، بل كدحٌ عقلي، وسعي ذهني، واجتهاد، وعمل، وجدّ، وكدّ، ونصب.
أغلى ما فيه ـ أي اعتداله ـ لا يُنال وأنت تحتسي شايًا فوق أريكة حريرية.
كم من فرقة ضلّت الطريق؟ عشرات وعشرات.
مبدأ الضلال في الفكر ومنهج العقل، وليس في الجارحة التي هي جندي مأمور، يفعل ما يؤمر به فحسب.
ب ـ الإسلام دين مركّب
على معنى أنه يجمع بين الأشياء والأمور، ويأخذ من كلّ شيء أحسنه ويدع خبيثه، وهو ما سُمّي شريعة الإقرار.
مركّب: بمعنى أنه يعتمد الوحي، ولكن العقل معه كذلك.
ولذلك قال أحد أكبر عظماء الإسلام بلا منازع (الغزالي): "نعرف الله بعقولنا، ثم تستقيل عقولنا لاستقبال التشريعات."
مركّب: بمعنى أنه يعتمد العقل، ولكن العقل الجمعي الذي يتحاور ويتشاور، وليس رأي المستبد.
ولذلك أنزل الله الشورى في حدقة العين وبؤبؤها، بين الصلاة والزكاة في سورة الشورى.
مركّب: بمعنى أنه يجمع بين الصلاح والإصلاح معًا، وأنه يعترف بالواقع لا لأجل تبريره، ولكن لأجل إصلاحه. ولا يقرّ إصلاحه عدا بما لا يعود بعد ذلك بمنكر مثله أو أكبر منه. وزوايا التركيب فيه لا تُحصى.
فطحل عظيم بكل مقاييس العظمة، وفي عيون حتى خصومه (ابن حزم)، لمّا حرم نفسه الطبيعة التركيبية للإسلام، فألغى القياس، جاء بعجائب وغرائب حطّت من قدره في تلك المواضع، لولا أنه جهبذ عوّض ذلك بنُجب أخرى.
تَصوّر لو أنه قال بالقياس ـ والذي نفسي بيده ـ لكان أفقه من كلّ فقيه بعد الفاروق وابن عباس.
ج ـ الإسلام دين المقاومة
مقاومة النفس قبل كل شيء، ومقاومة كلّ طاغوت قبل كل شيء، وقبل كل مقاومة.
بل تلك هي فريدته، ووحيدته، ويتيمته، وعجيبته، وأمّه، وفؤاده، وبؤبؤ عينه: مقاومة الطاغوت.
الطاغوت العقلي قبل الطاغوت المادي.
الإسلام مبناه وأسفله وأغدقه: التحرير.
ما جاء عدا ليحرّر الإنسان، والإنسان كائن عاقل مريد، يتحرّر بعقله، ثم يحرّر غيره بالعقل.
الرسالة هي التحرير، والوسيلة هي العقل.
لماذا ضلّ أئمة كثيرون في أيامنا ـ أيام طوفان الأقصى؟
لأنهم لم يفقهوا أن الإسلام أمّه العظمى، ولبّه الأكبر، إنما هو التحرير، ولا شيء غير التحرير، وأن وسيلته إلى ذلك المقاومة.
وأن الله يريد الآخرة، وليس الدنيا.
ولذلك عاتب الصحابة أنفسهم في غزوة أحد، إذ أهمّت بعضهم الدنيا فهُزِموا.
تنكّبوا أنّ إعادة تبوئة سورة البقرة ـ وهي الآخرة نزولًا ـ في صدر الكتاب العزيز، إنما هو لغرض واحد، اسمه:
يا أمة محمد ﷺ، لا عدوّ لكم ـ وقد أُكمل لكم دينكم ـ عدا الطائفة الإسرائيلية (الجنس اليهودي أولًا)، ثم الجنس النصراني ثانيًا.
ولذلك تلتها أختها الزهراء الثانية: آل عمران.
هل كان ذلك الترتيب ـ الذي لم يألفه الصحابة في عهده ﷺ ـ عبثًا معبوثًا؟
أمثلة من المقاصدية:
أحرّر مثالًا أو مثالين على الأكثر بغرض التذكير بأن تنكُّب المقاصدية ـ ولكن بشروطها المذكورة أعلاه: جزء من المشهد وليست المشهد كلّه. وأنها كذلك تالية للأصولية، وليست متقدمة عليها. وأنها في مقابل الوسائلية، وليس النصية ـ لا مناص منها لحُسن الفهم والتنزيل معًا. فإن تنكّبت: فلا فهم إلا كما فهم الخوارج ـ غابرًا وحاضرًا ـ ولا تنزيل إلا كما نزّلوا هم ومن يريد علمنة الإسلام.
المثال الأوّل:
ثبَت عليه السلام أنه نهى عن صبغ الشَّعر ـ المقصود شعر اللحية، لأنّ الرأس عادة ما يكون في تلك الأيام تحت عمامة ـ ولكن صبغ بعض الصحابة، منهم أبي، وهو {أقرؤنا}، بالسواد. فلمّا رأى منهم ذلك عليه السّلام، نهى عن الصبغ بالسواد، فما انتهوا. وأقرهم على ذلك. لماذا؟
لمقصد جليّ واضح، فقهه الصحابة، وهو أنه عليه السّلام كان يقصد أن صبغ الشعر الأبيض بالسواد، خاصةً، قد يُغرّ المرأة المخطوبة، فتظنّ ـ أو وليها ـ أن الخاطب شاب أو كهل، وهو في الحقيقة شيخ أو قارب الشيخوخة.
يعني فقهوا أنّ النهي معلَّل بالخديعة، فلمّا لا خديعة، لا نهي.
ومثل ذلك أمثلة بالعشرات (إسبال الإزار، وكثير مما تطفح به المعاركة اليوم حامية الوطيس بين المتدينين المُغفَّلين).
المثال الثاني:
نهيه عليه السلام عن (المُحتم والنقير) وغير ذلك، أي عدم تخليل شيء ـ عنب مثلًا أو تين أو غيرهما ممّا يُخلّل ـ في إناء مُحتَّم أو منقور، وسمّى أشكالًا أخرى. لأنّ ذلك في العادة يُحوّله إلى خمر، والخمر محرّم.
المقصود من ذلك النهي هو عدم تحوّل المُخلَّل إلى مُحرَّم، وليس المقصود الآلة نفسها، إذ الآلة وسيلة قد تتغيّر، بل حتمًا تتغيّر.
ومنه (المُزفّت) كذلك.
يعني: كلما لمستَ من نفسك عكوفًا على الأمر أو النهي ـ خارج دائرة المعتقدات والعبادات ـ من دون سؤال: لأي علّة ومقصد؟
أو عكفتَ على الشكل فحسب، ولم تنظر إلى ما وراءه، فأغلى النصيحة مني هي: راجع جهازك العقلي، إذ به عَطَب.
وما لا أرتاب فيه طرفة عين ـ والله ـ وهو غريب، أعرف غربته في زمن الفتنة العلمية والأُمِّيَّة الدينية، أن الله يوم القيامة سائلنا عمّا وعت رؤوسنا ـ وهو تعبيره هو نفسه عليه السلام في حديث الحياء ـ قبل سؤالنا عمّا حوت بطوننا، وقبل ما اقترفت جارحتنا.
ولكن من يؤمن بهذا اليوم؟ والله لو كفر به العالمون، لن أفرّط في أمر علمته من ديني كلّ علم.
خلاصة:
1 ـ المقاصدية ليست في مقابل النصية، ولكنها خادمة لها، بل هي روحها التي بها تحيا وتفعل، وهي جزء من المشهد العقلي، وليست مفصولة عنه.
2 ـ المقاصدية يمكن أن تكون أداة تمويع، وهذا صحيح، ولكن عندما يتقمّصها علماني أو جاهل، وفي وجه متدين جاهل. ولكن نجح العلماء المعتدلون في ردع المتعلمنين الذين يتخذون المقاصدية وسيلة تمويع للدين والتدين.
3 ـ ليس كالمقاصدية ـ وقد جرّبتُ هذا بنفسي ـ تعميقًا للنص والفهم، وفتحًا لآفاق ذهنية وعقلية واسعة رحبة، تُحبّبك في الدين والتدين. ولكنها لا تتقدّم الأصولية (أصول الفقه).
أصول الفقه يُجيب عن سؤال (كيف؟)، وأصول المقاصد عن سؤال (لماذا؟)، وكل مسافر يحتاج إلى (كيف؟) و(لماذا؟)، وإلا كان لاعبًا لاهيًا، لا جادًا.
4 ـ المقاصدية تؤمّن لك جمال الإسلام من خارجه، فلا تزهد في الاستمتاع بمنظر دينك من خارجه. ولذلك، فيما رأيتُ بعشرات الأمثلة ـ وإني لغابطهم والله ـ أن من أسلم من بعد كفر، عادةً ما يكون فَهمه أصحّ ممّن أسلم تقليديًا، من مثلي ومثلك ومثل الأكثرين، إلا من أخذ الإسلام بقوّة العلم، وليس بقوّة التقليد.
وإني لمع ابن حزم، القائل في مخالفة للعالمين، إنّ التقليد في العقائد حرام.
5 ـ بل عليك البحث عن مقاصد العقائد نفسها، كما دعا إلى ذلك ذات مرة قبل عقود الدكتور الريسوني، وما زالت البحوث في هذا شحيحة قليلة.
أجل، من علم مقاصد عقائده، فقد أمسك دينه من أُمّه، فهو له نور كاشف.
ومن اعتقد ولا يدري لماذا اعتقد، فقد قلّد.
لو ضاع كل عمرك في البحث عن مقاصد معتقداتك الستّ العُظمى، كُتبتَ عند الله من المجتهدين المجدِّدين الذين ينالون مثل ما ينال الشهداء المجاهدون، وربما أكثر.
أمّا تقديم الجهاد وتأخير الاجتهاد، فهو نفخة من نفخات إبليس، لو كنتَ تعلم أن دينك مُركَّب، لا أُحادي البعد، وجامع، وليس أحول.
والله أعلم.
- الكلمات الدلالية
- مقاصد
 الشيخ الهادي بريك
الشيخ الهادي بريك