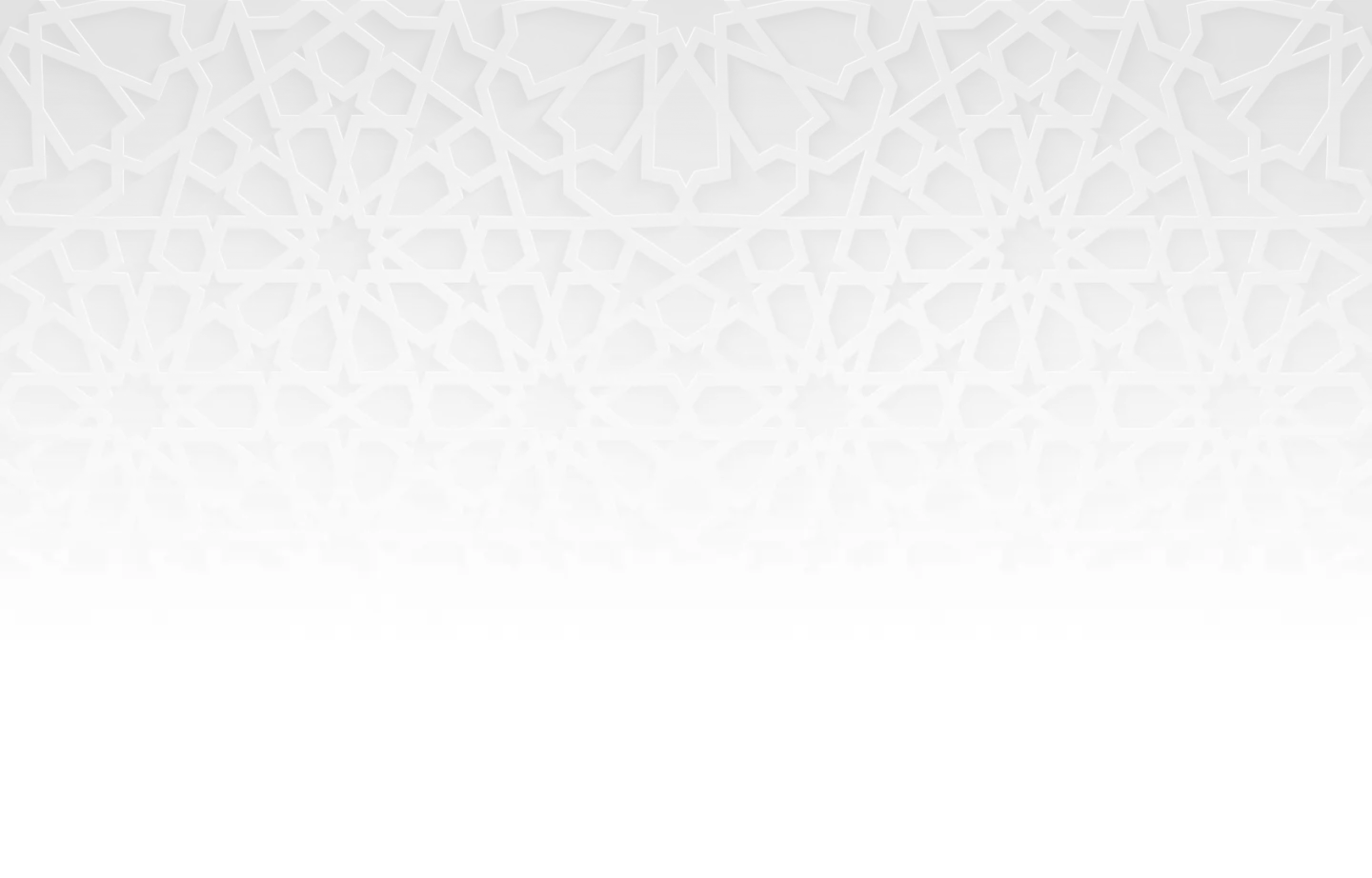
مقدمة تفسير القرآن الكريم | الإمام: محمود شلتوت (شيخ الأزهر سابقًا)

عُنِيَ المسلمون منذ فجر الإسلام، وانبثاق نور الهداية الإلهية على ربوع العالم، بالقرآن الكريم مصدر تلك الهداية، ومنبع ذلك الإشراق، عنايةً كبرى شمِلت جميع نواحيه، وأحاطت بكلّ ما يتصل به، وكان لها آثارها المباركة الطيبة في حياة الإنسان عامّة، والمسلمين خاصّة، وأفاد منها العلم، وأفاد منها العقل، وأفاد منها الدين، وأفاد منها الفنّ، وأفاد منها القانون والتشريع، وأفادت منها الفلسفة والأخلاق، وأفادت منها السياسة والحكم، وأفاد منها الاقتصاد والمال، وأفاد منها كلُّ مظهرٍ من مظاهرِ النشاط الفكري والعملي عرفه الناس في حياتهم المادية والروحية.
ولقد زخرت المكتبة الإسلامية من آثار هذا النشاط العظيم، بل زخرت مكتبات أخرى في لغات أخرى وأمم أخرى، بكنوزٍ رائعةٍ يقف العقل أمامها حائرًا مشدوهًا، أمام هذه العظمة التي لا كفاء لها إلا الإقرار بالعجز والخضوع!
ولكي ندرك مدى هذه العناية الكبرى التي تلقَّى بها المسلمون القرآنَ الكريمَ في جميع عصورهم ومراحل حياتهم، وعلى أيدي علمائهم وملوكهم ووزرائهم وأمرائهم وأغنيائهم وأرباب الفنّ فيهم، وأهل الإحسان في كلّ ناحية من نواحي الإحسان؛ لكي ندرس مدى هذه العناية الكبرى، علينا أن نلتفت إلى ما سجله التاريخ الفكري للمسلمين.
لا نكاد نعرف علمًا من العلوم التي اشتغل بها المسلمون في تاريخهم الطويل إلا كان الباعث عليه هو خدمة القرآن الكريم من ناحية ذلك العلم، فالنحوُ الذي يقوِّم اللسان ويعصمه من الخطأ، أُريد به خدمة النطق الصحيح للقرآن، وعلومُ البلاغة التي تبرز خصائص اللغة العربية وجمالها، أُريد بها بيان نواحي الإعجاز في القرآن، والكشف عن أسراره الأدبية، وتتبعُ مفردات اللغة، والتماس شواردها وشواهدها وضبط ألفاظها، وتحديد معانيها، أُريد بها صيانة ألفاظ القرآن ومعانيه أن تعدو عليها عواملُ التحريف أو الغموض، والتجويدُ والقراءاتُ لضبط أداء القرآن وحفظ لهجاته، والتفسيرُ لبيان معانيه والكشف عن مراميه، والفقهُ لاستنباط أحكامه، والأصولُ لبيان قواعد تشريعه العام وطريقة الاستنباط منه، وعلمُ الكلام لبيان ما جاء به من العقائد، وأسلوبه في الاستدلال عليها.
وقل مثل هذا في التاريخ الذي يشتغل به المسلمون تحقيقًا لما أوحَى به الكتابُ الكريمُ في مثل قوله: {نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ} [يوسف: 3]. {وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ} [هود: 120]. {وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ} [القمر: 4]، وقل مثل هذا أيضًا في علم تقويم البلدان وتخطيط الأقاليم، الذي يوحِي به مثل قوله تعالى: {سِيرُوا فِي الْأَرْضِ} [الأنعام: 11]. {فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا} [الملك: 15]. وفي علوم الكائنات التي يوحِي بها مثل قوله: {أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ} [الأنبياء: 30]. {أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ . يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ . وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} [النور: 43-45].
وهكذا علوم الفلك والنجوم والطب، وعلوم الحيوان والنبات وغير ذلك من علوم الإنسان، لا يخلو علمٌ منها أن يكون الاشتغال به في نظرِ من اشتغل به من المسلمين مقصودًا به خدمة القرآن، أو تحقيق إيحاءٍ أوحى به القرآن... حتى الشِّعر إنما اشتغلوا به ترقية لأذواقهم، وتربية لملَكاتهم، وإعدادًا لها كي تفهم القرآن وتدرك جمال القرآن، وحتى العَروض كان من أسباب عنايتهم به أنه وسيلة لمعرفة بُطلان قول المشركين: إنّ محمدًا شاعر، وإنّ ما جاء به الشعر.
وتبعًا لهذه الأنحاء المختلفة في نظر المسلمين إلى القرآن واشتغالهم به، نرى التفاسير ذات ألوان متنوعة؛ فمنها ما يغلب عليه تطبيق قواعد النحو وبيان إعراب الكلمات وبنائها، ومنها ما يغلب عليه بيان نواحي البلاغة والإعجاز، ومنها ما يهتم بالفقه والتشريع وبيان أصول الأحكام وهكذا.
ولعلّ مما يدلنا أيضًا على مدى هذه العناية أنّ الذين فاتتهم القدرة على معالجة القرآن من هذه النواحي العلمية، لم يفُتْهم أن يضربوا بسهمٍ في نواحٍ أخرى، جعلوها مظهرًا من مظاهر عنايتهم، وسبيلًا إلى نيل حظهم من رضا الله وثوابه، فهذا يكتب القرآنَ بخطٍّ جميلٍ، وهذا يزخرف صفحاته وأوائل سوره، وهذا يرقم آياته، وهذا يطرز سجله وغلافه، وهذا يرصد الأموال لتحفيظه، والمكافأة على التبريز فيه، وما زالت المساجد إلى يومنا هذا محتفظة بمظهر من هذه المظاهر هي تلك المقارئ التي يجتمع فيها القرّاء يتبادلون فيها قراءته وتجويده والاستماع إليه.
لهذا كله أعتقد أني لا أتجاوز حدّ القصد والاعتدال إذا قلتُ: أنه لم يظفر كتاب من الكتب سماويًّا كان أو أرضيًّا في أيّة أمّة من الأمم قديمها وحديثها بمثل ما ظفر به القرآن على أيدي المسلمين، ومَن شارك في علوم المسلمين. ولعلّ هذا يفسر لنا جانبًا من الرعاية الإلهية لهذا الكتاب الكريم الذي تكفّل الله بحفظه وتخليده في قوله: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} [الحجر: 9]، فما كان الحفظ والتخليد بمجرد بقاء ألفاظه وكلماته مكتوبة في المصحف، مقروءة بالألسنة، متعبَّدًا بها في المساجد والمحاريب؛ إنما الحفظ والخلود بهذه العظمة التي شغلت الناس، وملأت الدنيا، وكانت منارًا لأكبر حركة فكرية اجتماعية عرفها البشر!
ومن فضل الله علينا في هذا العصر، أنّ الرَّكْبَ سائرٌ لم يقف، ولم يفتر، وأن هذا الروح الكريم ما يزال يسيطر على المسلمين، وينتقل فيهم من جيلٍ إلى جيلٍ، يورثه الآباء للأبناء، وسيظل كذلك -إن شاء الله- حتى يرث الله الأرض ومَن عليها وهو خير الوارثين.
وهؤلاء هم المسلمون، على تفرقّهم في البلاد والأقاليم، وتفرقّهم في السلطان والنفوذ، وضعفهم المادي أمام دول الغرب، وبالرغم مما غُمِرُوا به وغُزُوا من علوم متنوعة، وثقافات متعددة ذات ألوان مادية، وأدبية، واجتماعية، وتشريعية؛ لا يزالون يعتصمون بالقرآن، ويدينون بقدسية القرآن، ويتآزرون على خدمة القرآن. وإنهم ليستشرفون جميعًا لمطلع ذلك اليوم الذي يعود فيه سلطان القرآن فيكون التشريع تشريع القرآن، والأخلاق أخلاق القرآن، والهدى هدى القرآن، ونرجو أن يكون قريبًا.
***
وإذا كان المسلمون قد تلقوا كتاب الله بهذه العناية، واشتغلوا به على هذا النحو الذي أفادت منه العلوم والفنون، فإن هناك -مع الأسفِ الشديدِ- ناحيتين كان من الخير أن يظلّ القرآن بعيدًا عنهما؛ احتفاظًا بقدسيته وجلاله، هاتان الناحيتان هما: ناحية استخدام آيات القرآن لتأييد الفِرَق والخلافات المذهبية، وناحية استنباط العلوم الكونية والمعارف النظرية الحديثة منه، وأحب أن أثبت على صفحات هذه المجلة، وبين يدي ما سأكتبه لها من التفسير، رأيي في هاتين الناحيتين واضحًا، فأقول:
أما الناحية الأولى: فإنه لما حدثت بدعة الفِرَق، والتطاحن المذهبي، والتشاحن الطائفي، وأخذ أرباب المذاهب، وحاملو رايات الفِرَق المختلفة، يتنافسون في العصبيات المذهبية والسياسية؛ امتدت أيديهم إلى القرآن، فأخذوا يوجِّهون العقول في فهمه وجهات تتفق وما يريدون، وبذلك تعددت وجهات النظر في القرآن، واختلفت مسالك الناس في فهمه وتفسيره، وظهرت في أثناء ذلك ظاهرة خطيرة، هي تفسير القرآن بالروايات الغريبة، والإسرائيليات الموضوعة التي تلقَّفها الرواة من أهل الكتاب، وجعلوها بيانًا لمجملِ القرآن، وتفصيلًا لآياته، ومنهم من عُني بتنزيل القرآن على مذهبه أو عقيدته الخاصّة، وبذلك وجدت تحكّمات الفقهاء والمتكلمين وغلاة المتصوفة وغيرهم ممن يروِّجون لمذاهبهم، ويستبيحون في سبيل تأييدها والدعاية لها أن يقتحموا حمى القرآن، فأصبحنا نرى مَن يُؤَوِّل الآيات لتوافق مذهب فلان، ومن يخرجها عن بيانها الواضح، وغرضها المسوقة له، لكيلا تصلح دليلًا لمذهب فلان، وبهذا أصبح القرآن تابعًا بعد أن كان متبوعًا، ومحكومًا عليه بعد أن كان حاكمًا!
كانت هذه ثورة! ثورة غير منظمة، عقدت حول القرآن غبارًا كثيفًا حَجَبَ عن العقول ما فيه من نور الإرشاد والهداية، وكان من سوء الحظّ أن صادفت هذه الثورة عهد التدوين، فحُفِظَتْ ودُوِّنَتْ كثيرٌ من الآراء الباطلة في بطون الكتب، وأخذت -بحُكْم الأقدميّة ومرور الزمن- نوعًا من القداسة التي يخضع لها الناس، فتلقّاها المسلمون في عصور الضعف الفكري، والانحلال السياسي كقضايا مُسَلَّمة، وعقائد موروثة لا يسوغ لهم التحلل منها، ولا الاعتداء عليها، ولا التشكيك فيها.
قيّد هذا التراثُ العقولَ والأفكارَ بقيود جَنَتْ على الفكر الإسلامي فيما يختصّ بفهم القرآن، والانتفاع بهداية القرآن، فجمد الناس على تقليد هذه الكتب واتخذوها حَكَمًا بينهم، واعتقدوا أنه لا يصح لمؤمن أن ينكر شيئًا منها، وقالوا: هذا شيء درج عليه السابقون والمتقدمون ودوّنوه في كتبهم، وشرحوا به كتاب الله، وتلقته الأمة بالقبول، وما كان لنا -ولسنا بأعلم منهم بالدين، ولا بأبعد نظرًا في فهم أساليب القرآن وتخريج الأحكام- أن نحيدَ عما تلقيناه منهم قِيد شعرة، ولا أن نخالفه في قليلٍ ولا كثيرٍ، وبذلك أسلموا عقولهم إلى غيرهم، وجنوا على أنفسهم بحرمانها لذة التفكير، وجنوا على دينهم باعتقاد أن هذه الأوهام من الدين، وقعدوا عن النظر في القرآن، وامتلأت أذهانهم بألوان من الأوهام الفاسدة عن التشريع والعقيدة، وما يحلّ وما يحرم، وصار كثيرٌ من المسلمين يعتقد أن الحلال ما أحلّه فلان في كتاب كذا، وأن الحرام ما حرّمه في كتاب كذا، بل وصل الأمر ببعض أهل العلم إلى أن يقول: إنّ هذا الشيء ثابت في القرآن؛ لأن فلانًا وفلانًا حملوا عليه بعض آيات الكتاب الحكيم.
وأما الناحية الثانية: فإنّ طائفة أخرى هي طائفة المثقفين الذين أخذوا بطرف من العلم الحديث، وتلقنوا، أو تلقفوا شيئًا من النظريات العلمية والفلسفية والصحية وغيرها، أخذوا يستندون إلى ثقافتهم الحديثة، ويفسرون آيات القرآن على مقتضاها.
نظروا في القرآن فوجدوا الله سبحانه وتعالى يقول: {مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ} [الأنعام: 38] فتأوّلوها على نحوٍ زَيَّن لهم أن يفتحوا في القرآن فتحًا جديدًا، ففسروه على أساس من النظريات العلمية المستحدثة، وطبقوا آياته على ما وقعوا عليه من قواعد العلوم الكونية، وظنوا أنهم بذلك يخدمون القرآن، ويرفعون من شأن الإسلام، ويَدْعُون له أبلغ دعاية في الأوساط العلمية والثقافية.
نظروا في القرآن على هذا الأساس فأفسد ذلك عليهم أمر علاقتهم بالقرآن، وأفضى بهم إلى صور من التفكير لا يريدها القرآن، ولا تتفق مع الغرض الذي من أجله أنزله الله، فإذا مرّت بهم آية فيها ذكر للمطر، أو وصف للسحاب، أو حديث عن الرعد أو البرق، تهللوا واستبشروا وقالوا: هذا هو القرآن يتحدث إلى العلماء الكونيين، ويصف لهم أحدث النظريات العلمية عن المطر والسحاب وكيف نشأ وكيف تسوقه الرياح. وإذا رأوا القرآن يذكر الجبال أو يتحدث عن النبات أو الحيوان وما خلق الله من شيء، قالوا: هذا حديث القرآن عن علوم الطبيعة وأسرار الطبيعة. وإذا رأوه يتحدث عن الشمس والقمر والكواكب والنجوم، قالوا: هذا حديث يثبت لعلماء الهيئة والفلكيين أن القرآن كتاب علمي دقيق.
ومن عجيب ما رأينا من هذا النوع أن يفسر الناظرون في القرآن قوله تعالى: {فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ . يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ} [الدخان: 10-11] بما ظهر في هذا العصر من الغازات السامّة، والغازات الخانقة التي أنتجها العقل البشري فيما أنتج من وسائل التخريب والتدمير، يفسرون الآية بهذا ويغفلون عن قوله تعالى بعدها: {رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ . أَنَّى لَهُمُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ . ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ} [الدخان: 12-14].
روي أنّ رجلًا جاء ابنَ مسعود وقال له: تركتُ في المسجد رجلًا يفسّر القرآن برأيه، ويفسر قوله تعالى: {فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ} [الدخان: 10] بأن الناس يوم القيامة يأتيهم دخان فيأخذ بأنفاسهم حتى يأخذهم كهيئة الزكام، فقال ابنُ مسعود: «من عَلِمَ علمًا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل: الله أعلم، إنما كان هذا لأن قريشًا استعصوا على النبي -صلى الله عليه وسلم- فدعا عليهم بسنين كسنيّ يوسف فأصابهم قحط وجَهْد حتى أكلوا العظام، فجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى بينه وبينها كهيئة الدخان من الجَهْد».
وأغرب من هذا وأعجب أن يفسر بعضُ هؤلاء المفسرِين الحديثِينَ شأنًا غيبيًّا من شؤون الله الخاصة لم ينزل بتفصيله وحي، ولم يُطلع اللهُ على حقيقته أحدًا من خلقه، ببعض الظواهر الحاضرة التي اكتشفها العلم واهتدى إليها بنو الإنسان، يفسر: (الكتاب المبين) و(الإمام المبين) الذي تُحصَى فيه الحسنات والسيئات ويُعرض على أصحابها يوم القيامة، بالتسجيل الهوائي للأصوات، ويقول: أظهر العلم ذلك بالمخترعات البشرية، واستخدمه الإنسان فيما يختص بالأصوات، ولا يبعد أن يستخدمه فيما يختص بحفظ الحركات والسكنات والخواطر النفسية، والله القادر خلق الكون على هذه السنن لغاية أسمى من ذلك، هي محاسبة الناس يوم القيامة، وعرض أعمالهم عليهم، كشريط مسجل يضم جميع حركات الناس وسكناتهم وخواطرهم وأقوالهم، وما قدموا من عمل.
يقولون هذا ويفسرون به قوله تعالى: {عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى} [طه: 52]، وقوله تعالى: {وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا} [الإسراء: 13]، ويهجمون على الغيب بما لم يأذن به الله، ويجدون مِن العلماء مَن يؤيدهم ويشجعهم ويزكّيهم ويتمنى أن يُكثر الله من أمثالهم!
إنّ هؤلاء في عصرنا الحديث لَمِن بقايا قومٍ سالفين، فكّروا مثل هذا التفكير ولكن على حسب ما كانت توحي به إليهم أحوالُ زمانهم، فحاولوا أن يُخْضِعوا القرآن لِمَا كانت عندهم من نظريات علمية أو فلسفية أو سياسية.
ولسنا نستبعد إذا راجت عند الناس في يومٍ ما نظرية داروين مثلًا، أن يأتي إلينا مفسر من هؤلاء المفسرين الحديثِينَ فيقول: إنّ نظرية داروين قد قال بها القرآن منذ مئات السنين.
هذه النظرة للقرآن خاطئة من غير شك؛ لأن الله لم ينزل القرآن ليكون كتابًا يتحدث فيه إلى الناس عن نظريات العلوم ودقائق الفنون وأنواع المعارف.
وهي خاطئة من غير شك؛ لأنها تحمل أصحابها والمغرمين بها إلى تأويل القرآن تأويلًا متكلفًا يتنافى مع الإعجاز، ولا يسيغه الذوق السليم.
وهي خاطئة؛ لأنها تُعَرِّض القرآن للدوران مع مسائل العلوم في كلّ زمانٍ ومكانٍ، والعلوم لا تعرف الثبات ولا القرار ولا الرأي الأخير، فقد يصحُّ اليوم في نظر العلم ما يصبح غدًا خرافة من الخرافات، فلو طبقنا القرآن على هذه المسائل العلمية المتقلبة، لعرضناه للتقلب معها، وتحمل تبعات الخطأ فيها، ولأوقفنا أنفسنا بذلك موقفًا حرجًا في الدفاع عنه.
فلندع للقرآن عظمته وجلالته، ولنحفظ عليه قدسيته ومهابته، ولنعلم أن ما تضمنه من الإشارة إلى أسرار الخلق وظواهر الطبيعة إنما هو لقصد الحثّ على التأمل والبحث والنظر؛ ليزداد الناس إيمانًا مع إيمانهم.
وحسبنا أنّ القرآن لم يصادم ولن يصادم حقيقة من حقائق العلوم تطمئن إليها العقول. قيل: يا رسول الله، ما بال الهلال يبدو دقيقًا مثل الخيط، ثم يزيد حتى يعظم ويستوي ويستدير، ثم لايزال ينقص ويدق حتى يعود كما كان، لا يكون على حالة واحدة؟ فنزل قوله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [البقرة: 189].
وإنّك لتجد هذا في سؤالهم عن الروح حيث يقول عز وجل: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا} [الإسراء: 85]، أليس في هذا دلالة واضحة على أن القرآن ليس كتابًا يريد الله به شرح حقائق الكون، وإنما هو كتاب هداية وإصلاح وتشريع؟!
المصدر: المقالة الأولى من هذه سلسلة مقالات في مجلة «رسالة الإسلام» في تفسير القرآن الكريم، حيث نشرت في العدد الأول من المجلة بتاريخ ربيع الأول 1368هـ - يناير 1949م، وجعلها الشيخ مقدمة لسلسلة التفسير.
- الكلمات الدلالية
إدارة الإعلام





