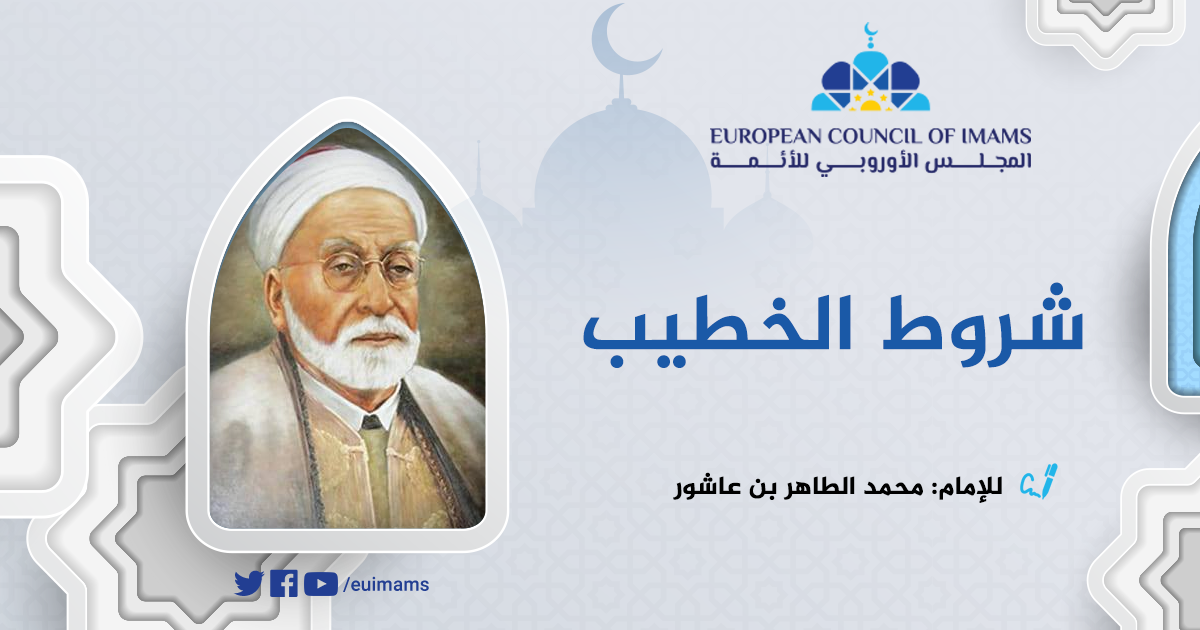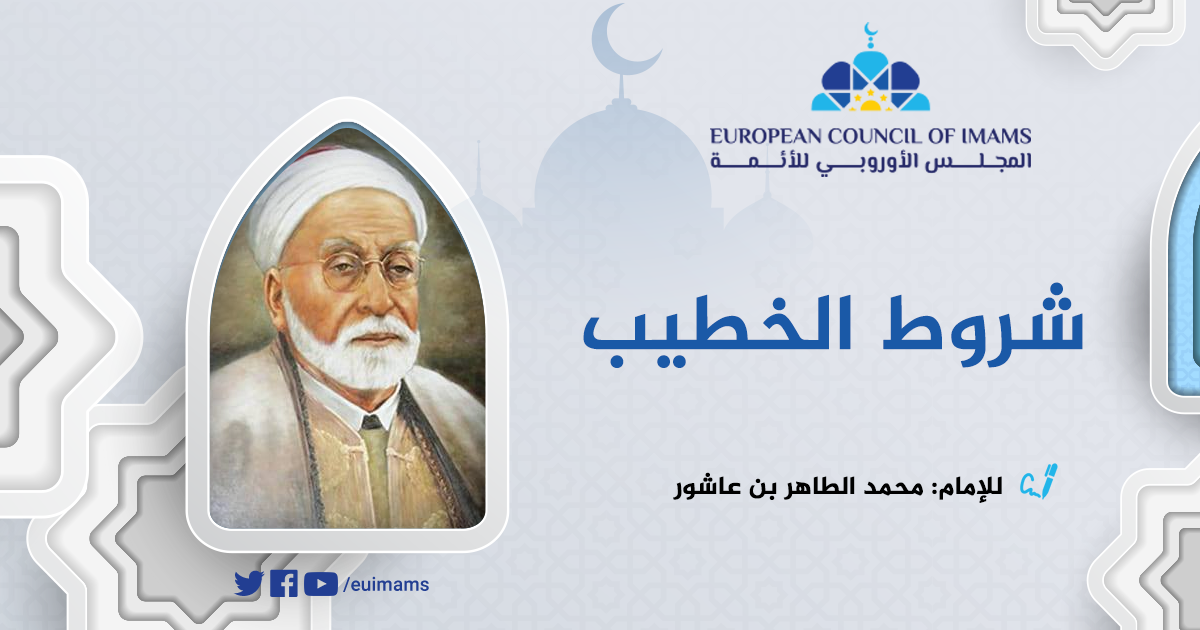
يتعلق الكلام على الخطيب بأمرين:
أحدهما: شروطه. وثانيهما: عيوبُه. لتحصل من معرفتِهما ما يجبُ اتِّبَاعه، وما يتعين عليه تركُه.
أما شروطُه فكثيرةٌ: منها: ما يَرجِعُ إلى ذِهْنِه. ومنها: ما يرجع إلى ذاته.
فأما شروط الخطيب الراجعة إلى ذِهْنِه فقد أرجعها أرسطو في كتابه في الخطابة إلى ثلاثة أشياء -هي كالأصول لها-:
أولها: معرفة الأقوال التي يحصل بها الإقناع. وثانيها: معرفة الأخلاق والفضائل الذاتية. وثالثها: معرفة الانفعالات، ومِنْ أيِّ شيءٍ تكون. ونحن نزيدها رابعًا وهو قُوَّة البَدَاهة في استحضار المعاني.
أما الثلاثة الأُوَل فقد شرحها ابن رشد في تلخيص كتاب أرسطو بعض الشرح، ونحن نزيدها بيانا فنقول:
أما معرفة الأقوالِ المُقْنِعَة فالمراد بها معرفة الأَقْيِسَة الخطابيَّة، وذلك يحصل من التمييز بين الأقيسة الصحيحة، والكُلِّيات وجزئياتها، والصادق والكاذب، ومراتب أنواع الحُجَّة، وذلك مما دُوِّن له علمُ المنطق، ولا نريدُ معرفتَه بصناعة المنطق؛ إذ قد كان الخطباءُ خطباءَ قبل تدوينِه، ولا يزال الخطباءُ خطباءَ ومنهم من لم يخطُر المنطق بباله، وإنما المراد أن تكون له مَلَكَةُ التمييز، سواء حصلت تلك المَلَكَة من سلامة
الفِطْرة وأصَالة الرَّأي، أم من مُزَاولة الفنون الحِكْمِيَّة، ويُلحَق بذلك معرفةُ الحقِّ والباطل، والمقبول والمردود، والصَّريح والخفي، والظاهر والمُؤَوَّل، ونضربُ لذلك مثلاً وهو كلما كان القولُ أعمَّ معنى كان أكثرَ تأتِّيًا لأن يُستعمَلَ في مواطن كثيرة، وكلما كان أخصَّ كان أوضحَ دِلالةً وأقربَ تناوُلاً، ولكلٍّ مَقَامٌ ووقتٌ ومخاطَبٌ، وهكذا معرفةُ العِلَل والغايات. وقد تقدم في جزء صناعة الإنشاء المعنوي من ذلك مَقْنَعٌ، وفي مُمَارسة علوم البلاغة والمنطق منه مَبْلَغٌ.
وأما معرفة الأخلاق والفضائل فالقصدُ من ذلك التمييزُ بين ما هو فضيلةٌ وضدِّه من الأفعال، ومعرفة محاسِن الأخلاق ومساوئها، فإن بمعرفة ذلك تحصيل غرضين مهمين:
أحدهما: رياضة الخطيبِ نفسَه على التَّحَلِّي بتلك الفضائل.
وثانيهما: معرفتُه ذلك من حال المخاطَبين؛ ليلقي لهم الكلام على قَدْر احتياجهم وبقدر ما تَهيَّأَت له نفوسُهم. وكأنَّ هذا الثاني موجِب اشتراط الاستيطان في خطيب الجمعة عند مَن اشترطه.
واعلم أن الخطيب لا غِنَى له عن معرفة أضداد الفضائل أيضًا؛ إذ قد يدعوه الحالُ إلى بيانها إما لِذَمِّ ما تشتملُ عليه وتُؤثِرُه، وإما لمعرفة ما فيها من منافع قليلة؛ لئلا يَبْهَتَه بها مَنْ يريدُ التَّضليلَ بترويجها، فإذا كان
عالمًا بتفاصيلها لم يعسُر عليه تفنيدُ من يضلِّلُ بها، وفي ذلك أيضًا عَوْنٌ على الدِّفَاع عن مُرتكِب هَفْوةٍ وصاحب فَلْتَة. وقد يكون الشيءُ نافعًا في وقتٍ، وضدُّه نافعًا في آخرَ، كالشَّجاعة وقت الحَرْب، والأَنَاة وقت السِّلْم.
وأما معرفة الانفعالات ومَنْشَئِها فهي من أكبر ما يعتمدُ عليه خطيبُ القوم؛ إذ به يُمَيِّزُ بين ما تنفعلُ به نفوس العامة، وما تنفعلُ به نفوس الخاصة، وما هو مُشترَكٌ بينهما، وبين أنواعِ الانفعالات خيرِها وشَرِّها، وقوَّتِها وضعفِها، وما هو مقبولٌ وما هو مردود. وقد تَعَرَّض أرسطو إلى ذلك بما عَبَّر عنه بـ (إثارة الأهواء) فقال: “إنها انفعالات في النَّفْسِ تُثِيرُ فيها حُزْنًا أو مَسَرَّةً”. وقال أفلاطون: “لكلِّ أمرٍ حقيقةٌ، ولكلِّ زمانٍ طريقةٌ، ولكلِّ إنسانٍ خَلِيقَةٌ، فالتمس من الأمور حقائقَها، واجْرِ مع الزَّمان على طرائقه، وعامِل الناسَ على خلائقهم”. فعلى الخطيب ألا يقيس الناسَ على حَذْوِ نفسِه؛ فإنَّ منهم مَنْ يُسَاويه، ومنهم مَنْ يفوقُه، ومنهم مَنْ هو دونه، وليس ما يزهد فيه الفتى -مثلاً- يزهد فيه الصَّبي، ولا ما يخاطَب به الجنديُّ في صَفِّ القتال يخاطَب به الحكيمُ؛ إذ رُبَّ مَحْمَدَةٍ عند هذا هي مَذَمَّةٌ عند الآخَر، فنحن ندعو كلاً منهما -إذا أَرَدْنا منه انفعالاً- بما يُناسِب اعتقادَه. ألا ترى أن حُبَّ التعظيم والفَخْر -مثلاً- لو زَهِد فيه الطِّفْل في المَكْتَبِ كما يزهَد فيه الحكيمُ لاستوى عنده العمَل والكَسل، ولم يهتمَّ بمنافسة أقرانِه فتَضَاءلتْ مواهبُه. وكذلك القناعة المحمودة لا يحسُن أن يذكرَها أو يدعوَ إليها مَنْ يخطُبُ في قومٍ تكاسلوا عن التِّجَارة وفشا فيهم الفَقْر، فإن جاء يخطُب فيمن أعرضوا عن تعاطي العِلْم، أو عن تهذيب النَّفْس لشِدَّة التعلُّقِ بالدنيا حَسُنَ أن يتعرَّض حينئذٍ لمحامد القناعة وأنها أكبرُ غِنًى.
وعلى هذا فالخطيب يُخاطِبُ السَّامعين بمقدار ما يَعْلَمُ من رُتْبَةِ انفعالهم بكلامه؛ فتَارةً يتوجَّه إلى ابتداء المطلوب منهم مِنْ غير طَلَبٍ لوسائلِه، ويَكِلُ لهم السَّعْيَ في وسائل تحصيله، وذلك إنْ عَلِم أن لا نُشُوزَ منهم. وتارةً يتطلَّب منهم تحصيلَ الأسبابِ والوسائل إن عَلِمَ منهم نُشُوزًا عن المطلوب لِيَقَعُوا في الأمر المطلوب بعد ذلك على غيرِ تَهَيُّؤٍ إليه، مثال ذلك: لو أراد أن يدعوَ إلى أَمْرٍ فيه صَلاحٌ عامٌّ مثل تكثير سَواد الأمة بالتَّنَاسُل، ويعلمُ من المخاطَبين بعض الإِجْفَال عن ذلك لِمَا يتوقَّعون من متاعب تربية البنينَ والبنات، فيقتضي الحالُ أن يدعوَهم إلى وسيلة ذلك وهو الحَثُّ على التَّزَوُّجِ مُظْهِرًا له في صفةِ السَّعْي لمنفعةٍ شخصيةٍ، مُرَغِّبًا فيه بما يعودُ من حُسْنِ الأُحْدوثَةِ أو بما يحصُل مِنْ أجر عاجل أو آجل.
وكذلك القولُ في حَمْلِ المخالفين على الشيء بالرَّغبة والرَّهبة، فإذا كان الخطيب معتمِدًا على قُوَّة، وعَلِم أنَّ للمخاطَبين من الحِدَّة والعصيان ما يُحبِط سعيَ الخطيب، فعليه أن يتَظاهرَ بقُوَّتِه بَادِئَ الأمر؛ ليَفُلُّ من تلك الحِدَّة، كما فعل الحَجَّاج يوم دخوله الكوفة بعد وقعة دَيْر الجَماجِم.
هذا وقد يجهل المتكلِّمُ في غرضٍ ضمائرَ الناس، ولا يَزِنُ مراتبَ عقولهم، فينبغي له أن يتفطَّن لِمَا يلوحُ عليهم من الانفعال، فيفاتحُهم بما يُثير انفعالَهم مِن أمورٍ صالحة لأغراض مختلفة، حتى يرى أَمْيَالَهم إلى أيَّةِ وِجْهَةٍ تُولِّي، فيعلم من أيِّ طريق يسلك إليها، ولا بد في هذه المُفَاتَحة من جَلْب التَّوْرِيَات والتَّوجيهات ونحوها، مما يمكن تأويلُه ويتيسَّرُ له عند إجفالِهم تحويلُه، حتى لا يَسترسِلَ في موضوعه فيعسُرَ عليه الرُّجوع إلى تعديله، وانظر ما قصَّه الله تعالى في كتابه الحكيم عن مؤمن آل فرعون: {وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ} فوَرَّى في اللَّوْمِ، أي كيف تفعلون هذا بِمَنْ يختارُ لنفسِه ربًّا. {وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ} وهذا ارتقاءٌ في الحُجَّةِ. {وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ} وهذا تزهيدٌ لهم في قتلِه، بتقديم احتمال الكذب ليظهر أنه قَصَد الإنصاف. {وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ} وهذا تحضيرٌ لنفوسهم إلى تَرَقُّبِ صدق مُعجِزَتِه ووعدِه. {إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ (28)} وهذا تَوْرِيَةٌ أيضًا، أي إنكم تنتظرون ما يتبيَّنُ من أَمْرِه، فإنَّ الله لا يُصدِّقُ الكاذبَ بخارِقِ العادة. {يَاقَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا} [غافر: 29]
وهذا توبيخٌ وتقريعٌ؛ لأنَّه قد أوجب بما تقدَّم انفعالَ نفوسِهم لِقَبوله، أي لا تكونوا سببًا لزوال سُلْطانِكم بالتعرُّضِ لسَخَط الله.
إذ لا شك أن هذا المؤمنَ الصَّالحَ كان يتَرقَّبُ مِنْ قومِه الإجْفَالَ والتَّكَشُّفَ على إيمانِه، فأظهَرَ لهم الكلامَ في مَظهِر المُتَرَدِّدِ الخائف مِنْ حُلُول المصائب به وبقومه، لا المُنتَصِر لموسى – عليه السلام -.
وإنما تظهرُ مَواهِب الخطيب وحِكْمتُه وبلاغتُه في هذا المقام؛ لأنَّ مَنْ تكلَّم عن احتراسٍ وسوءِ ظَنٍّ بسامعيه حَاطَ لِنَفْسِه من الغَلَط؛ لأنَّ شِدَّة الثِّقَةِ بالنَّفْس تُغَطِّي على عَوارِها فلا يَتَّقِيه ربُّها.
ومن هذا أن يتركَ لنفسه بابًا لتَدارُك فائت، كما قال الحريريُّ في المقامة الثانية والعشرين -بعد أن ذكر استرسال أبي زيد السَّروجِيِّ في تفضيل كتابةِ الإنشاء على كتابة الحِسَاب-: “فلما انتهى في الفَصْل، إلى هذا الفَصْل، لَحَظ من لمَحَات القوم أنَّه ازْدَرَع حُبًّا وبُغْضًا، وأرضَى بعضًا وأَحْفَظَ بعضًا، فعَقَّب كلامَه بأن قال: ألا إنَّ صِنَاعة الحساب موضوعةٌ على التَّحقيق، وصناعة الإنشاء مَبنِيَّةٌ على التَّلفيق”. هذا إن كان المتكلِّم مُفَاتِحًا بالكلام، فأما إن كان مُجِيبًا فقد يلاحظ من أصول المُجَادَلة ما يطول بسطُه هنا، وعلى كلِّ حال فعليه أن يَخْتَبِئ للمعترضين من الرُّجُوم، ما يَقِيه وَصْمَة الإرْتَاج عليه أو الوُجُوم.
وأما الأمر الرابع وهو قوَّة البَدَاهَة في استحضار المعاني وسماه أبو هلال في الصناعتين بـ (انتهاز الفرصة) فهي من أهمِّ ما يلزم
الخطيب؛ إذ ليس يخلو من سامعٍ يدافع عن هواه، أو عدوٍّ يترصَّدُ سَقَطات الخطيب ليُري الحاضرين أنه ليس على حقٍّ فيما قال، أو مُجيبٌ يُجيبُ عن تَقْريع الموعظة.
فإن لم يكن الخطيبُ قويَّ البَداهَة أَسْكَتَه المعترِضُ أو المجيبُ، وقد كان عمرُ – رضي الله عنه – مرَّةً يخطُب يوم الجمعة فدخل عثمان – رضي الله عنه – فقال له عمر: “أيَّةُ سَاعةٍ هذه؟ ! ما بالُ أقوامٍ يسمعون الأذان ويتأخرون. فقال عثمان: ما زِدْتُ على أن سمعتُ الأذان فانقلبتُ فتوضَّأت. فقال له عمر: والوضوءَ أيضًا! وقد علمتَ أنَّ رسول الله – صلى الله عليه وسلم – كان يأمرُ بالغُسْل”. ويُعين على ذلك تنبُّهُه لِمَا في كلام المجيب من مَجَاري الخَلَل ومواضع النَّقْد.
وأما شروطُ الخطيب في ذاتِه:
فمنها: جَوْدَةُ القَرِيحة، وهي أمرٌ غيرُ مُكتسَب، وقد قال موسى – عليه السلام -: {وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي (27) يَفْقَهُوا قَوْلِي (28)} [طه]، وسيأتي
لذكر اكتسابها كلامٌ في عيوب الخطباء. قال أبو هلال: “مِن الناس مَن إذا خلا بنفسه وأَعْمَل فِكْرَه أتى بالبيان العجيب، واستخرجَ المعنى الرَّائق، وجاء باللفظ الفائق، فإذا حاوَر أو ناظَر قَصَّر وتأخَّر، فخَلِيقٌ بهذا ألا يتعرَّض لارتجال الخُطَب. ومنهم مَن هو بالعكس.
ومنها: أن يكون رابط الجَأْش، أي غير مُضطَرِبٍ في فَهْمِه ولا مندَهِش؛ لأنَّ الحَيْرة والدَّهَشَ يصرِفان الذِّهْنَ عن المعاني فتجيءُ الحُبْسَة ويُرتَج على الخطيب”.
ومنها: أن يكون مرموقًا من السَّامعين بعين الإجلال؛ لِتُمْتَثَلَ أوامرُه، ويحصلُ ذلك بأمور كثيرة:
منها: شَرَفُ المَحْتِد، قال الشاعر:
لَقَدْ ضَجَّتِ الأرْضُونَ إِذْ قَامَ مِنْ بِني بني … سَدُوسٍ خَطِيبٌ فوقَ أَعْوَاد مِنْبَر
وكذلك: حفظ العِرْض؛ بحيث لا تُحفَظ له هَنَةٌ أو زَلَّةٌ، وقد رُوي عن عمر – رضي الله عنه – أنه قال: “احذر من فَلَتاتِ الشَّباب، كُلَّ ما أَوْرَثَكَ النَّبَز وأَعْلَقَك اللَّقَب، فإنه إن يعظُمْ بعدها شَأْنُك يَشتدَّ على ذلك نَدَمُك”. وفي متابعة آداب الإسلام والوقوف عند شرائعه مِلاك ذلك كلِّه.
ومثل ذلك: رَجَاحَة الرأي وقوُّة العِلْم والحكمة، قال أبو واثلة يهجو عبد الملك بن المهلب:
لقد صَبَرَتْ للذُّلِّ أعوادُ مِنْبَرٍ … تقومُ عليها في يديك قَضِيبُ
بكى المِنْبَرُ الغَرْبِيُّ إذ قُمْتَ فوقَه … فكادت مَساميرُ الحديدِ تذوبُ
رأيتُك لمَّا شِبْتَ أَدْرَكَكَ الذي … يُصِيبُ سَرَاةَ الأَزْدِ حين تَشيبُ
سَفاهَةُ أحلامٍ وبُخْلٌ بِنَائلٍ … وفيك لِمَنْ عَابَ المَزُونَ عُيوبُ
فهذه أهمُّ الشروط الذاتية.
ويَعُدُّ علماء الأدب تارةً صفاتٍ أخرى هي بالمحاسن أشبه، مثل سكون البَدَن وقت الكلام؛ لأنه دليلٌ على سكون النَّفْس، ولا يوجد هذا في كل خطيب.
ومثل ما سماه أرسطو بـ (السَّمْت) وهو أن يكون على هيئة مُعْتبَرَةٍ في نفوس الجمهور من لُبْسِه وحَرَكتِه ونحو ذلك، وقد أشار الحريريُّ إلى هذا في المقامة (28) فقال: “برَزَ الخطيبُ في أُهْبَتِه، مُتَهَادِيًا خَلْفَ عُصْبَتِه”. فأشار إلى تصنُّعِه في لباسه ومشيه.
ومثل مناسبة طَبَقَةِ الصَّوْت لموضوع الخطبة وغير ذلك.
وأما شروط الخطيب في نفسه فأهمها:
اعتقادُه أنه على صواب وحقٍّ؛ لأنَّ ذلك يودِع كلامَه تأثيرًا في نفوس السامعين، وأقوى له في الدعوة إليه والدفاع عنه، ويحصُلُ ذلك بالتزامه متابعةَ الحقِّ، وبكونه على نحو ما يطلبُه من الناس. وانظر ما حكاه الله تعالى عن شعيب – عليه السلام -: {قَالَ يَاقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ (88)} [هود].
ومنها: عِفَّتُه ونزاهتُه.
ومنها: الوَقَار والصَّون عن الابتذال في معاشرة القوم، وعدم الإكثار من الهَزْل والسُّخْف والفُحْش والخِفَّة والطَّيْش.
ومنها: النَّزَاهة عن الطَّمَع في جَرِّ نَفْعٍ من كلامه؛ فإنَّ في ذلك نُفْرَةً عن اتِّعَاظ الناس بقوله، وظِنَّةً في صِدْق دَعْوتِه، وقد قال السَّروجيُّ بعد أن قام خطيبًا:
لَبِسْتُ الخَمِيصَةَ أبغي الخَبيصَهْ … وأَنْشَبْتُ شِصِّيَ في كُلِّ شِيصَهْ
ولقد يجدرُ بنا إذ بَلَغْنَا هذا الموضعَ أن نختِمَه بذِكْر بعض عيوبٍ يكثُر عُروضُها للخُطَباء ليتنبَّه المُطَالِعُ إلى تجنُّبِها.
واعلم أنها تنقسم إلى فطري وإلى مكتسب:
فأما الفِطْريُّ فمنه ما يمكن تجنُّبُه بكثرة الممارسة، نحو: الحُبْسَة عند التكلُّم، فقد كان عمرو بن سعد بن أبي العاص -البليغ الخطيبِ- في أول أمره لا يتكلَّم إلا اعْتَرَتْه حُبْسَةٌ في مَنْطِقِه، فلم يزل يَتَشَادقُ ويُعَالِجُ إخراج الكلام حتى مال شِدْقُه مِنْ كثرة ذلك، ولُقِّب لذلك بـ (الأشدق) فقال فيه الشاعر:
تَشَادَقَ حتى مَالَ بالقَوْلِ شِدْقُهُ … وكلُّ خطيبٍ لا أبا لكَ أَشْدَقُ
وقد اعتقد الناس فيه حين انتقل من الحُبْسَة إلى الفصاحة أن الجِنَّ لطَمَتْهُ على وجهِه ليتعلَّم الفصاحة، وكذلك كان اعتقادهم في الشُّعراء أن الجن تَتَراءى لهم وتُمْلِي عليهم، فقال في ذلك الشاعر:
وعمرٌو لَطِيمُ الجِنِّ وابنُ محمَّدٍ … بأسوأ هذا الرأيِ مُلْتَبِسَان
وسبَّه رجلٌ يومًا فقال له: “يا لَطِيم الشيطان، ويا عاصي الرحمن”.
ومِنْ قَبْلُ حُكِي مثل هذا التدرُّب عن ديموستين خطيبِ اليونان في عهد الإسكندر الأكبر، وقد تقدم ذلك في مقدمة قسم الإنشاء.
ونحو سقوط الأسنان، وكان عبد الملك بن مروان رحمه الله قد شَدَّ أسنانه بالذهب لما كبِرت سِنُّه وقال: “لولا المنابرُ ما باليتُ متى سَقَطَتْ”.
ومن العيب الفِطْري ما لا يمكن تجنُّبُه كبُحَّةِ الصوت، والفَهَاهَةِ، واللُّثْغَةِ ببعض الحروف وضِيق النَّفَس فجديرٌ بصاحبها أن يتجنَّب هذه الصِّنَاعة.
وأما العيب المكتسب فهو أشياء تعرِض للخطباء في أول اشتغالهم بالخطابة من أفعالٍ تصدُر عن غير اختيار، فإن هم غفلوا عن مراقبة أنفسهم لإزالتها صارت لهم عوائدَ سيئةً، وقد نَهى الأدباءُ عن أمورٍ من ذلك، كالتَّنَحْنُح، ومَسْح اللِّحْية في أثناء الخطبة لا عند الشروع -على أنه يُغتفَر منه ما لا يَكثرُ، إذا طال الكلامُ جدًّا- وحكُّ الجِلْد، وفَتْلُ الأصابع، وكثرةُ حَرَكة الأيدي والبَدَن، والتمخُّط، وغيرُه. قال مَنْ ذمَّ خطيبًا:
مليءٌ بِبُهْرٍ والتفاتٍ وسَعْلَةٍ … ومَسْحَةِ عُثْنُونٍ وفَتْلِ الأصابع
من كتاب: أصول الخطابة والإنشاء
بقلم: محمد الطاهر ابن عاشور (1296 – 1393 هـ = 1879 – 1973 م) رئيس المفتين المالكيين بتونس وشيخ جامع الزيتونة وفروعه بتونس.