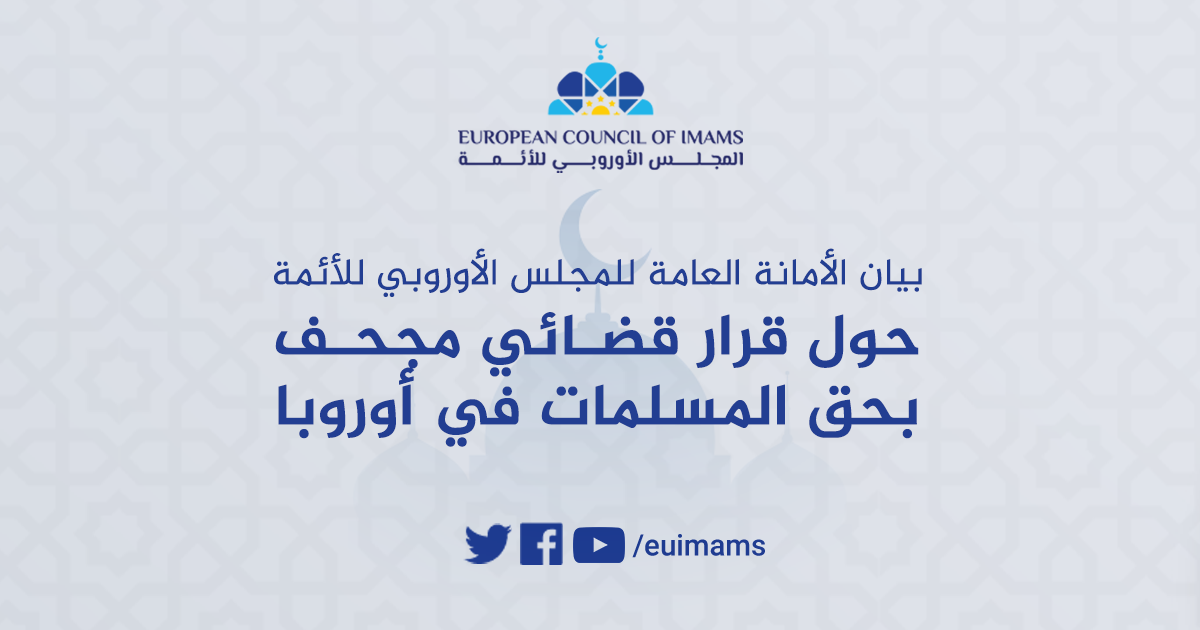في ذكرى المولد الشريف | لماذا ندرس السيرة النبوية ؟ وماذا نتعلم منها؟
إنَّ أهم مقصد لبعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم هى أن يعلم الناس فقه النجاة، أو بعبارة الإمام أبو الحسن الندوي {علم النجاة} وهو نفس الطريق الذي خطا عليه النبيون من قبله وبُعث صلى الله عليه وسلم مكملاً ومتمماً لرسالتهم، فما أحوج الإنسانية لهديه وتعاليمه ورسالته، ماذا يظفر المرء إذا حاز المال كله وفقد روحه ونفسه؟ ماذا تُغني أعلى الشهادات العلمية إن جهل الإنسان خالق الأكوان جل في علاه وغفل عن لقائه؟
لو حاز المرء أموال الدنيا وأصبح أغنى إنسان في الحياة لكنه يعيش لنفسه ولا يفكر في محرومٍ أو مسكينٍ، ولم يحزن ولا يشعر بآلام ومعاناة الضعفاء فإنه حيئنذ قد فقد إنسانيته، لهذا فإن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم إنقاذ للبشرية من الدوران حول نفسها وجعل الدنيا محور كل شيء.
لقد نفخ سول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم في جسد الإنسانية الخامد حتى تكون الدنيا في أعين الناس وقلوبهم مَعبراً وممراً يوصلها إلى دار القرار.
جاء الرسول ليقول للإنسان أنت سيدٌ في الكون ولك قيمةٌ عظيمةٌ، ولا يصح أن تكون عبداً للكون، لا يصح أن تكون خادماً للأشياء من حولك، إن لك رسالة تتجاوز خدمة الجسد إلى الروح والقلب والناس من حولك.
ورحم الله الإمام أبو الفتح البستي حينما قال:
يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته أتطلب الربح فيما فيه خسران
أقبل على النفس واستكمل فضائلها فأنت بالروح لا بالجسم إنسان
لقد حقق العالم انجازاتٍ كبيرةٍ في ميدان العلم والمعرفة والحضارة في جانبها المادي مما لم يحلم به السابقون لكن السؤال هنا: هل الإنسان سعيد في زماننا؟ هل يشعر بطمأنينة النفس وسكينة الروح ؟ أم أنه نسي أن له روحا تتطلب عذاءً ودواءً من نوع آخر؟
هل أدرك يوما أنه لو فقد الرضا والغاية من الحياة فلن يستفيد كثيراً، ولو سكن قصراً مُنيفا وتوفرت له كل أسباب الراحة؟
لقد جاء محمد صلى الله عليه وسلم ليملأ قلوب الناس بمحبة الله، وخشيته وتقواه، ومعرفه قدره وجلاله، ويدلهم وينير لهم طريق الحياة، قال تعالى: (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ) الأنبياء: 107
قصة وعبرة
أورد الإمام الندوي قصة معبرة أردت أن أثبتها هنا: {يًحكى أن فريقا من تلاميذ المدراس ركبوا سفينة للنزهة في البحر وكان المجدف رجل أمي فخاطبه تلميذ جريء وقال يا عم: ماذا درست من العلوم؟ قال له: ولا شيء، قال: أما درست العلوم الطبيعية؟ قال: كلا ولا سمعت بها، وتحدث الثاني: أما درست الجبر والمقابلة؟ قال: أول مرة أسمع هذه الأسماء، ثم تحدث التلميذ الثالث ساخراً: ولكنني متأكد أنك درست الجغرافية والتاريخ؟ فقال: هل هما اسمان لبلدين، أو علمان لشخصين؟
وهنا علت أصوات الشباب بالضحك على الرجل قائلين: لقد أضعت نصف عمرك يا عمنا..
وبعد قليل هاج البحر وماجت الريح واضطربت السفينة وأصبحت السفينة في مواجهة الغرق، وكانت أول تجربة للشباب في ركوب البحر.
وجاء دور الملاح وتحدث في هدوء ووقار: ما هي العلوم التي درستموها يا شباب؟ وبدأ الشباب يتلًون قائمة طويلة بالعلوم التي درسوها دون أن يفطنوا لمقصد الملاح، ثم قال لهم: لقد درستم كل هذه العلوم يا أبنائي فهل درستم علم السباحة؟ وهل تعرفون إذا انقلبت السفينة لا قدر الله كيف تسبحون وتصلون إلى الشاطئ بسلام؟ قالوا: لا
قال: إذا كنت ضيعت نصف عمري كما قلتم فقد أضعتم عمرك كله، وما تغني عنكم تلك العلوم أمام هذا الطوفان {. انتهى باختصار وتصرف
ولا يفهمن أحد التقليل من شأن العلوم المعاصرة ودروها في عمارة الحياة وإصلاح الأرض، بل المقصود أن تكون تلك العلوم خادمة للقيم دائرة في منضبطة بالأخلاق، فإن الإنسان المعاصر قد جنى الشقاء والتعاسة حينما أصحبت العلوم في خدمة أهوائه ورغباته وشهواته، لهذا نقرأ قول الله تعالى:
{اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (1) خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (2) اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ (3) الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (4) عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (5)}
فكل قراءة ينبغى أن تدور حول تحقيق المقاصد الكبرى لخلق الإنسان.
ونقرأ قوله تعالى: {الرَّحْمَنُ (1) عَلَّمَ الْقُرْآنَ (2) خَلَقَ الْإِنْسَانَ (3) عَلَّمَهُ الْبَيَانَ (4)}
واجبنا في ذكرى مولده الشريف
وفي ذكرى مولد رسول الله عليه وسلم فإن أفضل ما نفعله أن نعكف على سيرته الشريفة، نتامل هداياتها، ونستبط أحكامها، ونستخرج كنوزها، ونداوي جراحاتنا بأدويتها الشافية الكافية، ونعزم على التأسي والقرب الروحي من شخصية حبيب الحق محمد صلى الله عليه وسلم، وتلكم بعض مقاصد مدارسة السيرة الشريفة:
1- الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، امتثالا لقوله تعالى (لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا} الأحزاب: 21
ورسول الله هو القدوة الكاملة لجميع الناس في مختلف جوانب حياتهم، وكل من قصد التأسي به سيجد مبتغاه في أرقى مثال وأعظم صورة، فهو قدوة الشاكرين والصابرين، قدوة الأقوياء والضعفاء، قدوة الحاكمين والمحكومين، قدوة الأغنياء والفقراء، قدوة الشباب والشيوخ، قدوة الأصحاء والمرضي، قدوة الأزواج والآباء، قدوة الدعاة والمصلحين والمربيين، قدوة العابدين والسالكين إلى الله، قدوة القانعين من الحياة والمقبلين عليها، وقد كان كل هذا وأكثر صلى الله عليه وسلم.
يقول الإمام ابن القيم في كتابه {عدة الصابرين} عندما وقع النزاع في أفضيلة الغني الشاكر عن الفقير الصابر فقال: { احتج بحال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل واحدة من الطائفتين، والتحقيق أن الله سبحانه وتعالى جمع له بين كليهما على أن الوجوه، وكان سيد الأغنياء الشاكرين وسيد الفقراء الصابرين، فحصل له الصبر على الفقر ما لم يحصل لأحد سواه، ومن الشكر على الغنى ما لم يحصل لغنى سواه، فمن تأمل سيرته وجد الأمر كذلك، فكان صلى الله عليه وسلم أصبر الخلق في مواطن الصبر، وأشكر الخلق في مواطن الشكر، وربه تعالى كمل له مراتب الكمال فجعله في أعلى رتب الأغنياء الشاكرين، وفي أعلى مراتب الفقراء الصابرين} .
كان إذا شرب ماءً يرى فيه وافر النعم الوافدة من ربه جل وعلا، فليهج لسانه بالشكر لمن أطعم وسقى وأروى من ظمأ، فيقول: الحمد لله الذي جعله عذباً فراتاً برحمته ولم يجعله ملحاً أجاجاً بذنوبنا) وأبان لنا أن شكر النعمة لا يتطلب من العبد كثير عمل بل يكفى أن يعترف المرء بقلبه بمصدر مُوجدها وواهبها ثم ينطق بلسانه ما وقر قلبه، وليستمتع بها على النحو الذي يرضى الرحمن جل في علاه.
هذا مقام شكره في القليل فما بالنا فيما هو أعظم، لقد رأيناه يُفني جسده في محراب العبادة حتى تورمت قدماه وقد استغرق في لذة وصاله مع ذي الجلال والإكرام، وعندما تقول له أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها: لم تصنع هذا وقد غفر الله لك؟ فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟
وأما ما أصابه صلى الله عليه وسلم من هم وكرب وتعب وإيذاء فكان فيه القدوة لكل مهموم وحزين ومبتلى.
لقد ذكرتُ يوما سيدنا يعقوب عليه السلام حينما فقد ولده يوسف عليه السلام وبلغ به الحزن المدى وتمكن منه الكرب حتى ابيضت عيناه عليه السلام، غير أنه استقبل قدر الله قائلا: (فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ۖ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ) يوسف: 18 وطال البعاد ودام حزن قلبه على حبيبه، ثم ابتلاه الله تعالى بابنه الآخر فزاد في ثباته وصبره مكررا (فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ۖ عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ) يوسف: 83
وذكرتُ امرأةً عرفتها في مصر فقدت ولدها وهو شاب صغير فمكثت حزينة عليه حتى توفاها الله، ثم ذكرتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت: إن فقد الولد أفجع ما يصيب الإنسان في الحياة، فما بالنا أن رسول الله عليه وسلم فقد ستة من أبنائه في حياته، لكنه طوى حزنه بين جنبيه ولم يشغل الناس بهمومه، نعم…لقد بكى وحزن، ولما رأه بعض الصحابة وقطرات طاهرة من عينيه الشريفتين تنزل حزنا على فراق ولده، تعجب فقال صلى الله عليه وسلم : إنها رحمة، ثم قال: إن العين لتدمع، وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، وإنا لفراقك ياإبراهيم لمحزونون، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
لو شاء أن يكون ملِكا في الدنيا لكان له ما يريد، لكنه آثر الآخرة ومشاركة أصحابه حياتهم، ومقاسمتهم معاناتها كواحد منهم، لم يكن أحد يعرفه من جلسائه، وإن كانت الأَمَةُ لتأخذ بيده حيث شاءت، لا يحجب عن أحد بِشره ومودته، لم يكن ينزع يده من يد من يصافحه حتى ينزع الآخر، وكان يُقبل على مُحدثه بوجهه كله، يعظم الكبير ويرحم الصغير.
وجد يوما أم سعد ابن معاذ رضى الله عنه قادمةً من بعيدٍ فوقف لها تقديراً واحتراماً، فانظر لرقة الشعور وكسب القلوب. دخل عليه رجل وهو يرتجف، فقال له هَون عليك، فإنما انا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة، كان ينهى أصحابه أن يبالغوا في مدحه وكان يقول: إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد، يبدأ جليسه بالكلام ليأنسه، يواسي طفلا صغيرا مات عصفوره قائلا: يا أبا عمير مافعل النُغير؟
لم يعرف التاريخ أنبل منه خُلقاً، ولا أرَق منه شعوراً، ولا أرقى منه عاطفةً، ولا أزكى منه نفساً.
إنه القدوة الكاملة، كان في مكة مستضعَفا وأصحابه يواجهون الأذى، فما لانت عزيمته ولا كلَّت إرادته ولا ضعف قلبه، بل ثبت على مبادئه ولم يساوم عليها رغم التحديات الكبيرة، ولم يزده الإيذاء إلا إصراراً على دعوته والتمسك برسالته، لكن القرآن كان الدواء الشافي والبلسم الذي يخفف الأحزان ويزيل الهموم، يقول له ربه جل وعلا: (وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ*فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ) الحجر: 97-99
وحينما يزاد تكذيب المشركين للقرآن وللرسول ويفترون على الله الكذب تنزل الآيات: (قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ ۖ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ) الأنعام: 34
(فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون) يس: 76
2- حسن فهم القرآن الكريم
يقول شيخنا الغزالي في فقه السيرة: {إن القرآن روح الإسلام ومادته، وفي آياته المحكمة شرح دستوره، وبسطت دعوته، وقد تكفل الله بحفظه فصينت به حقيقة الدين، وكتب لها الخلود أبد الآبدين والرجل الذي اصطفاه الله لإبلاغ آياته وحمل رسالته، كان قرآنا حيا يسعى بين الناس، كان مثالا لما صوره القرآن من إيمان وإخبات.
إن الله اختاره ليتحدث باسمه ويبلغ عنه فمن أولى منه بفهم مراد الله فيما قال؟ ومن أولى منه بتحديد المسلك الذي يتواءم مع دلالات القرآن القريبة والبعيدة؟} .
لن نستطيع أن نفهم القرآن الكريم فهماً دقيقاً حتى نعود إلى سيرة من أُنزل عليه، فالسيرة هى التطبيق العملي لتعاليم القرآن وأحكامه وآدابه، كما أن القرآن الكريم ضابط لفهم السيرة وتمحيص مروياتها في ضوء نصوصه وقواعده ومقاصده العامة.
وقد نزل القرآن مُنجماً بقصد صناعة المجتمع والأفراد وصياغة شخصياتهم ومعالجة القضايا التي تستجد في حياة المسلمين في الصدر الأول، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يترقبون نزول آيات الذكر الحكيم بتلهف وشوق، ومن مباحث علوم القرآن: ” أسباب النزول “أى: أن هناك آيات نزلت لأسباب وأحداث خاصة لهذا يجب علينا أن نعرف الأسباب والظروف والملابسات التي نزلت فيها هذه الآيات الكريمة حتى نحسن فهمها، ويؤسفني أن بعض الشباب المسلم ونفراً من غير المسلمين لا يفهمون آيات القتال على نحو صحيح، وذلك لعدم لعلمهم بأسباب نزولها والمقصود بها والظروف التي نزلت فيها، وإن من أكبر الإفتراءات على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حمل السيف وأعلن حرباً لا تهدأ على البشرية ولم يترك لهم خياراً إلا الإسلام أو السيف…وهذا غير صحيح مطلقا، وما علينا إلا أن نعود للسيرة النبوية وأحداثها لنتيقن من أنه صلى الله عليه وسلم ما بدأ أحداً يوما بعدوان ولا استحل مال أحد ولا عِرض إنسان.
3- التحقق بمحببته صلى الله عليه وسلم.
يقولون: من أحب شيئا أكثر من ذكره، وإذا أردنا أن تتعمق محبته في قلوبنا وتخالط روحنا فعلينا أن نعيش سيرته، ونعرف شمائله، ونقترب من حياته، يقول بعض المسلمين: ليتنا أدركنا عهد الرسول وعشنا معه، ولا ريب أنه دلك شعور إيماني عظيم بيد أن دليل صدق ما نقوله هو أن نكون قريبين من سيرته وأخلاقه فنسير على خطاه ونطيعه في أمره ونهيه، إن محبته فرض على كل مسلم، بل إن محبته يجب أن تلى محبة الله تعالى كما قال صلى الله على وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده والناس أجمعين.
والحب الصادق الحي في القلب يأتي بالقرب ممن تحبه لتتعلم منه وتقتدي به وقد تعجب المشركون من حب الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم على نحو لم يسمعوا به من قبل ولم يروا أحدا يحب أحدا كما يحب الصحابة رسول الله وقد قالوا ذلك في مناسبات متعددة.
وعندما نعرف السبب يزول بعده العجب، لقد ملك حب الرسول على الصحابة قلوبهم وانفسهم مما رأوا من صفاته وأخلاقه العظيمة، وتعالوا بنا نعيش معه صلى الله عليه وسلم، ونقول: ستحبه عندما …ستحبه عندما تراه في غار حراء وهو وهو يناجي ربه ضارعا إليه بعيدا عن الدنيا والناس، في عام 2008 كنا في رحلة عمرة مع الشباب وانطلقنا إلى غار حراء الذي ضم جسد أطهر إنسان في الوجود، والذي استقبل أنوار الوحي، وكم أحسسنا بالرهبة حينما اقتربنا من هذا المكان الذي يبعد عن مكة قرابة خمسة كليومتر، لقد تحول هذا المكان الموحش إلى روضة من رياض الجنة مع حضرة الرسول الأعظم وأنوار القرآن الكريم، لقد غيَّر معادلة النظر للأشياء، فالسكينة الداخلية والسعادة القلبية منبعها القلب وليس طبيعة المكان الذي يعيش فيه الإنسان، فالوحشة أساسها بُعد القلب عن الله، ولهذا يقول الإمام ابن تيمية: المسجون من حبس قلبه عن ربه والمأسور من أسره هواه.
وقد كان سحرة فرعون بعد إيمانهم أكثر حرية رغم العذاب الذي لاقوه فقالوا لفرعون الطاغية لما توعدهم بالتنكيل الشديد :
}قَالُوا لَن نُّؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا ۖ فَاقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ ۖ إِنَّمَا تَقْضِي هَٰذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا* إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ ۗ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ} طه: 72-73
لقد بقى الرسول صلى الله عليه وسلم ستة أشهر يتردد على هذا الغار متعلق القلب بالله متأمل الفكر دائم النظر حتى جاءه الروح الأمين.
ستحبه وهو يطوي بساط النوم ويهجر الراحة من أجلنا ويقول لسيدة خديجة: مضى عهد النوم يا خديجة، ومند الأمر الإلهي: قم فأنذر لم يعرف جسده راحة ولم تر عينه نوم ولم يهدأ عقله من التفكير والتدبير ولم يدخر دقيقة إلا في هداية الناس.
ستحبه وهو يمر على أصحابه المعذبين عمار وسمية وبلال وغيرهم ولا يملك لهم إلا الدعاء و كلمات التثبيت والتبشير بالفرج وزوال المحنة.
سستقول ليتني كنت معك يا زيد بن حارثة أتوقى الحجارة عن رسول الله معك حينما قذفه المشركون والسفهاء في الطائف وأشاركك الشرف العظيم، وستقف طويلاً معه حينما رفض أن يدعو على قومه بعد كل هذا الشرود والاضطهاد. وكان يقول: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون.
ستقول من قلبك: بأبي انت وأمي يا رسول الله حينما تراه ساجداً أمام العكبة الشريفة والمشركون حوله يضعون على ظهره الشريف الأذى وابنته فاطمة تذرف الدمع تزيل عنه الأذى وهو يقول لها: لا تخشى يا بنية على أبيك فإن الله ناصر أباك.
ستحبه أكثر وأكثر كلما اقتربت منه وجلست بين يديه تتعلم منه كيف تحب الله وترجوه لقاه، كيف تخافه وتخشاه، ستحبه حينما تتعلم منه كيف تحب الناس من حولك وترجو لهم السعادة والنجاة، ستحبه كلما صليت عليه.
ستحبه وتفديه بروحك عندما تدرك سر وجودك في الحياة وأنه لولاه ما عرفت طريق الحق والهدى، ودعونى أسوق لكم بعض ما سطره يد شيخنا محمد الغزالي رحمه الله في كتابه ” مع الله ” وهو يوضح لنا بعض فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا يقول طيب الله ثراه: {كم من السنين كنت سأقضيها بحثا وراء الحق الذي أهدانيه محمد صلى الله عليه وسلم وأنا في ضمير الغيب ؟
وكم من الآلام كنت أعانيها وأنا أنفق العمرةفي تجارب قبل أن أهتدى إلى السداد؟
ومن الذي يضمن لي مع قدرتي أن أظفر بالحقيقة الغالية، وقد تاه عنها رجال تشابهت عليهم الطرق حينا، وانسدت في وجوههم المنافذ حينا آخر؟؟
وهبني أوتيت قدراً من الذكاء الكشاف، والنشاط الدءوب، فمن للألوف المؤلفة من الناس الدين قلت حظوظهم المعنوية؟ وكيف يحيون على ظهر الأرض؟؟
إنني كلما أحسست راحة الإيمان في نفسي، وبرد اليقين في قلبي، وروعة الدين الذي ينير باطني، أشعر بميل شديد إلى شكر الرجل الذي يسر لى هذا الخير، وأتاح لى أن أعرف ربى الواحد جل شأنه، وأن أقدر النعمة التي حولي وأدري من بُعث بها.
نعم إنني أشعر بميل شديد إلى شكر محمد صلى الله عليه وسلم والتنويه بفضله، والثناء على صنيعه كلما غسلت وجهي في وضوء، وطهرت بدني لصلاة، ووضعت وجهي على الأرض ساجدا أسبح ربى الأعلى !!!
نعم، وكلما سرت في الطريق منتصب القامة، رافع الرأس، عزيز النفس، أرمق الكبار والصغار على أنهم عبيد مثلي لله الذي أدعوه وحده وأرجوه وحده.
وكلما شعرت بأني إنسان أعرف من أين جئت؟ وإلى أين أصير؟ ولماذا خلقت، وماذا أفعل وماذا أترك؟
وكلما تصورت أن هناك بشرا كثيرين، تكتنفهم الحيرة والظلمة لأنهم محرومون من ذلك المتاع المتاح لى، أحسست أن في عنقي وعنق كلمؤمن مثلي دينا للرجل الطيب الكريم الذي مهد لنا بجهاده هذا الصراط المستقيم، لمحمد صلى الله عليه وسلم.
4- التعريف بالرسول صلى الله عليه وسلم
إن أكثر الناس في الأرض يجهلون حقيقة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وأعتقد أننا لو قمنا بدراسة ميدانية عن صورة رسول الإسلام في أذهان كثير من غير المسلمين لوجدنا أنننا بحاجة لجهود كبيرة من أجل التعرف بأخلاقه وشمائله العظيمة ووصاياه الخالدة وسيرته الشريفة ومحو الصورة السلبية التي تم الترويج لها عبر قرون طويلة في فترات توتر العلاقات بين الشرق والغرب والتي امتدت ردحا من الزمان.
ولا أبالغ إن قلت إن كثيراً من المسلمين حول العالم لا يعلمون من سيرته العطرة إلا نزراً يسيراً، ولعنا نتابع بعض مقاطع الفيديو التي ترصد مستوى الثقافة الإسلامية عند الشعوب العربية والإسلامية فنرى العجب العاجب، فما بالنا بأبنائنا هنا في أوروبا ؟!
يقول الشيخ محمد الغزالي رحمه في مقدمة كتابه: فقه السيرة: {إن المسلمين الآن يعرفون عن السيرة قشوراً خفيفة لا تحرك القلوب، ولا تستثير الهمم، وهم يعظمون النبي وصحابته عن تقليد موروث ومعرفة قليلة، ويكتفون من هذا التعظيم بإجلال اللسان، أو بما قلت مؤنته من عمل}.
جاءني رجل فاضل بعد صلاة الجمعة وقال لي: لقد دخلت في نقاش مع جارتي الألمانية صاحبة السبعين عاماً، فقال لها: ما تعرفين عن نبي الإسلام؟ قالت: غاية ما أعرفه، أنه كان رجلاً كبيراً في العمر يسطو هو وأصحابه على أموال الناس، ويتزوج الفتيات الصغيرات !!
قال لها متعجباً: أهذا فقط ما تعرفينه؟ قالت نعم، فشرح لها شطرا من سيرته العطرة وأخلاقه الزكية وتعاليمه الحضارية حتى أصابها ذهول مما سمعت.
قلت: كم من امرأة مثلها في ألمانيا وأوروبا والعالم تلك حصيلتها من معرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
إن دورنا كبير في تعريف المسلمين والأجيال الجديدة من أبنائنا ف الشرق والغرب برسول الله صلى الله عليه وسلم وغرس محبته في قلوبهم، وحق الإنسانية علينا أن نعرفهم برسول الحق وحبيب الله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بقلم: الشيخ/ طه عامر.