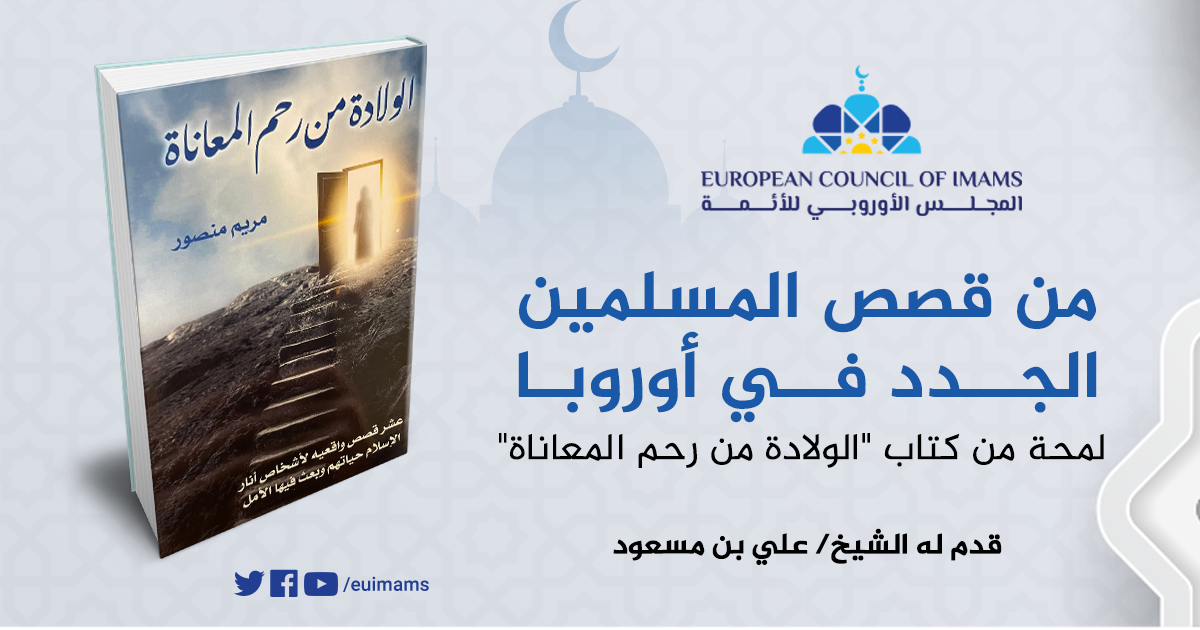يتطور الحضور المسلم بأوروبا من حيث الكم والكيف يوماً بعد يوم، وكى نتجنب تشتت الجهود، والانشغال بالوسائل عن الغايات، والأعمال كثيرة الكلفة ضعيفة الأثر عن الأعمال الأكثر انتاجاً، فعلينا أن نرهق عقولنا قليلا لتحديد أفضل الأعمال من فاضلها، وأولاها بصرف الجهود والأوقات، لذلك يلزمنا أن ندندن حول عدد من الأولويات التي يجب أن ننغشل بها في المرحلة القادمة، وسوف أشير إلى عدد منها، تاركاً بقيتها إلى مقالات أخرى بحول الله تعالى.
العناية بالتربية والتكوين
تؤدي الأعمال والأنشطة الجماهيرية دوراً كبيراً في التعريف بالإسلام وتعاليمه وأخلاقه وآدابه، إلا أنَّ من الخطأ الذي نقع فيه _ أحيانا – أن نصرف كثيراً من طاقاتنا في الوسائل العامة والبرامج الجماهيرية،إلى تتحول إلى غاية وهو في الأصل وسيلة، دون أن نراجع نتائجها، والأصل أن الوسيلة إذا تقاصرت عن تحقيق مقصودها وجب العدول عنها إلى غيرها، بعد التدقيق والتمحيص.
وترانا نرهق كوادرنا من الشباب حتى يستنفذوا قدراتهم، وعلى الجانب الآخر لا ننفق معشار هذا الجهد في العمل التكويني التربوي الذي يُفضى إلى صناعة القيادات واكتشاف المواهب وتوظيفها، مما يؤدي إلى ضمور العمل، ثم نشكو من قلة العاملين.
والمتتبع لنشاط العديد من المؤسسات الإسلامية على الساحة الأوروبية يتجلى له بجلاء تراجع في الكفاءات والكوادر، وفقدان لطاقات عديدة لأسباب مختلفة، ما بين المرض أو التقاعد المبكر، أو حصاد كورونا لكثير من أهل الفضل، أو غير ذلك من الأسباب.
ولا ريب أننا أمام تحد كبير للحفاظ على مؤسساتنا، وحسن أدائها، وتطويرعملها، ومن ثمَّ يجب أن يتوجه قسط كبير مما نملك من الوقت والجهد والمال إلى التربية، إلى العناية بالجيل الناشيء، من مهد طفولته، إلى يفاعته، إلى شبابه.
والسؤال من أين نبدأ ؟
عمود الخيمة، ومفتاح الباب، وأساس البناء، وحجر الزاوية، هو المربي، فلا بديل عن العناية بالبدء به، اختياراً، وتكويناً، وتوجيهاً، وترشيداً، وبناءً. والقاعدة: “ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب “. فالوسيلة حكمها هنا من حكم الغاية.
إذاً، فليكن سعينا في العام الجديد، العناية بالمربي، بالمعلم، بتكوين الآباء، سيما في عصرنا الذي تتعرض له الأسرة لغوايات إبليسية مدججة بأخطر الأساليب والحيل الماكرة التي تبغي استئصال بنيانها، وهدم أركانها، ومسخ هويتها، وتعطيل وظيفتها، وإفساد فطرتها، وتلويث براءتها.
على المؤسسات الإسلامية والمساجد أن تصنع برامج تكوينية للمربين والمشرفين وتنفق في ذلك الجهد والمال.
التربية الروحية دواء العصر
من أدواء عصرنا، أن رأس الإنسان أصبح أكبر من حجمه، فثَقُل به بدنه، ولم تعد تحمله أقدامه، وغدا يعاني من فرط الشهوات، وهزال الروح، فإنه وإن سكن قصراً مُنيفا ضاق عليه، وإن تسربل بالحرير قال ما أخشنه، وإن استهلك من الطعام أطيبه، حسد كانس الطريق إن وجده هاديء البال، مرتاح الضمير، وإن تسجَّى على لين الفراش، تقلَّب تقلُّب المحموم، يطارده القلق والأرق.
ومن ثم علينا أن نبذل جهداً كبيراً في تفعيل الوسائل التربوي التي تُطهر القلب وتُنقيه، وتُجمل الخلق وتُرقيه، وتُقوي الضمير وتُزكيه، وتُهذب السلوك وتُنميه.
وحسبنا القرآن العظيم دليلاً ومرشداً وموجها ًومعيناً، وهو الشفاء لما في صدرونا من الشهوات، ولعقولنا من الشبهات، ولحياتنا من المطامع والمتاعب.
ثم نُولي وجهنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سيرته المباركة لنستروح بها، ونستهدي به، ونقبس من أنوراه، ونتفيأ ظلال أصحابه الغُر الميامين، فنجدد بسيرتهم إيماننا، ونستجلب الرحمات بمحبتهم ومدراسة حياتهم، وإذا كانت الرحمات تتنزل بذكر الصالحين، فما بالنا إذا ذكرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا ذكرنا أصحابه عليه الرضوان.
العمل المشترك مع مؤسسات المجتمع المدني.
يتمتع المجتمع الأوروبي في عمومه بتعظيم دور المجتمع المدني وتأثيره في الحياة بمختلف مجالاتها، على عكس المجتمعات التي تسود فيها الأنظمة الاستبدادية، التي يتعاظم فيها حجم الدولة على حساب والأفراد والناس.
مساحات واسعة وفرص كبيرة لا نستفيد بها على الوجه المأمول، وأعني بذلك فرص التشبيك مع مؤسسات المجتمع المدني.
وما يزيد الشعور بالتقصير أن تلك المؤسسات حريصة على تشريك شرائح المجتمع في الأعمال التي تدخل في اختصاصها. أذكر ذات مرة أنني تحدتث في خطبة الجمعة عن أهمية العمل التطوعي مع مؤسسات المجتمع المدني، وأنَّ رسالة المسلم تقتضي أن يكون له حضور ظاهر وأثر واضح، وبعد الفراغ من الصلاة سألني بعض الشباب قائلين : أليس الأَولى أن نركز على تنظيم أنفسنا أولاً، والعمل على إنجاح مؤسساتنا ومساجدنا، ثم نلتفت بعد ذلك إلى المجتمع والعمل التطوعي الذي تُحدثنا عنه؟
قلت : لو أننا انتظرنا حتى يكتمل بناء مساجدنا مادياً ومضمونياً ثم نخرج للمجتمع فأبشركم أننا سنبقى حبيسي جدران مساجدنا، لا أثر لنا ولا دور، وبقاء الجماهير الغفيرة من الأوروبين لا يدرون عنا إلا ما يسمعوه من غيرنا، لا ما يروه ويقفوا على حقيقته من خلال معاملتنا ومشاركتنا في حمل هموم المجتمع وآماله وآلامه.
ترى لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا، هل يرضى بهذه الهمة الخامدة والغاية القاصرة؟
ألم يكن يصل الرحم، ويحمل الكَل، ويُكسب المعدوم، ويعين على نوائب الدهر؟
ألم يأمرنا الحق تبارك وتعالى أن نفعل الخير بشكل مطلق، كما في آخر سورة الحج.. وجعل صناعة الخير ثمرة طبيعية لتفاعل القلب مع الجوراج مدفوعا بقوة الإيمان بالله الرحمن الرحيم.
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۩ «سورة الحج 77»
إن الناس عامة لا تتأثر بالكلام الحسن، والبيان الرصين بقدر ما تتأثر بالفعل الذي ينشر السعادة، والسلوك الذي يرسخ للسلام، والمشاعر التي تُرسي المحبة والطمأنينة.
هل يعني كلامنا أن لا حضور لنا في جنبات العمل التطوعي بالمجتمع الأوروبي ؟
بالطبع لا، فإن كل مسلم حول العالم عليه أن يفخر بالنماذج العظيمة الرائدة المشرقة لمسلمي أوروبا الذين يتفانون في خدمة أوطانهم دون النظر إلى مغنم سوى مرضاة الله تعالى وخدمة مجتماعتهم ورفاهيته، فأينما التف على مستوى أوروبا قاطبة، وجدت آلاف المساجد التي تُسهم بصدق في أمن وسلامة المجتمع الأوروبي من خلال خطابها المعتدل، وحضها المسلمين دوما على أن يكونوا مواطنين صالحين منتجين نافعين للناس… كل الناس، على اختلاف عقائدهم وألوانهم.
إن رصيد المسلم من حب الخير وصناعته، والعطف على الضعفاء والكف عن إيذاء الناس وحفظ أموالهم وأعراضهم رصيد وافر، ذلك لأن القرآن الكريم – الذي يجهله رسالته ملايين البشر- هو من يؤسس للرفاهية الروحية، والسلامة المجتمعية، والراحة النفسية، والطمأنينة القلبية.
عشرات الألوف من الشباب المسلم الأوروبي يمثلون اليوم والغد أملاً كبيراً لأوروبا في المحافظة على المكتسبات الحضارية، والنهوض الاقتصادي، والتطور العلمي.
وقد أثبتت أزمة كورونا في العاميين الماضيين المسؤولية العظيمة التي أظهرتها المؤسسسات الإسلامية قاطبة في الحفاظ على سلامة المجتمع رغم ما تطلبته من خسائر مادية كبيرة، سيما والغالبية الساحقة من المساجد لا تتلقى درهماً ولا ديناراً من هنا أوهناك.
ولو أردتَ تتبع ملامح الإسهام الحضاري لمسلمي أوروبا لمجتماعتهم، فهذا ما يقصر عنه مقال أو كتاب، بل يستدعي ذلك دراسات وافية.
إننا لا نرسم صورة مثالية، بل نرى مساحات الإشراق والإنجازات، وفي الوقت ذاته نعاين جوانب الخلل والتقصير، فنحمد الله تعالى على التوفيق لفضائل الأعمال، ونستغفر من النقص والتأخر، ثم نبحث عن الثغرات الخالية فنسدها، قدر الوسع والطاقة.
ما آمله في عامنا الجديد أن يكون لكل مسجد وكل جمعية صغيرة أو كبيرة سهم وافر في العمل التطوعي مع مؤسسات المجتمع المدني، مثل / التطوع ساعات في الإطفاء/ مع جمعيات الرفق بالحيوان/ جمعية المحافظة على البيئة / جمعيات مكافحة العنصرية / أطباء بلا حدود / إلخ….
صناعة النفسية الإيجابية عند مسلمي أوروبا
منذ نزل القرآن الكريم على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ” اقرأ بسم ربك الذي خلق “، منذ هذا اليوم فتح الرحمن الرحيم طريق النور والأمل للإنسانية، فمن يقرأ بسم الله، ويكتب بسم الله، ويشق طريقه في الحياة بسم الله،ويتعلم بسم الله، ويُعلم الجاهل بسم الله، ويلتمس سبيل النجاة للحيارى بسم الله، ويعمل ويُنتج بسم الله، ويقطع البر والقفر بسم الله، ويعبر البحر ويخترق الجو بسم الله، ويقارع الظالمين بسم الله، ويصلح ما اعوجَّ من السلوك والأفكار والمشاعر بسم الله، لن يعرف اليأس إلى قلبه باباً، ولن يتسلل الشك إلى عقله، ولن يهتز يقينه أمام موجات الماكرين هنا أو هناك.
كلماتٌ يجب أن تختفي من قاموس المسلم في الشرق والغرب، تلك التي تُعبر عن سخط أو تشاؤم أو قنوط، ففي عصرنا وفي كل عصر نجد الصعوبات الفردية والأسرية والجماعية، وتلك طبيعة الحياة، والحكمة من وقوع الأكدار في هذه الدار، كما ذكر القرآن الكريم في عديد السور، وإلا لما خلق الله الجنة والنار في الآخرة.
لن يقول يوما : لا أقدر، ولن يتردد في إيمانه بأن له إردة حرة، ولن يعجز، وسيرى النور ويعيش بالأمل يحدوه العمل، ومن أمَرهُ أن يردد في كل صلاة : ” إياك نعبد وإياك نسعين ” سيمده بالصبر والقوة والعزيمة، وإن ضعف يوما – لأنه بشر – سيربط الله على قلبه، وإن سأل الله تعالى العون سيجد برد اليقين وضياء الإيمان يفتح له الطريق.
قد يخفق المرء في عمله الخاص أو العام، غير أنه لن يجلس باكياً على اللبن المسكوب يعض أصابع الندم، بل سينطلق معتبراً من الأخطاء، يعوض فشل الأمس بنجاحات كثيرة، يعرف بعدها حكمة الله تعالى في زلته الماضية بعد أن تألَّم وتعلَّم. وحينها يعلم أن ثمن الخطأ أقل بكثير مما تعلمه وتداركه، وليس في ذلك دعوة لاستصغار الأخطاء، إنما حفز للمسلم أن يستقبل ولا يستدبر، إلا بقدْر ما يقيه عثرات الماضي.
تلك هى النفسية الإيجابية التي لا تستسلم للمصاعب والتحديات، ولا تنهزم نفسيا، بل تقابل التحديات بالأفكار العملية والبرامج التطبيقية. وحسبنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: “استعن بالله ولا تعجز” رواه مسلم
نريد في عامنا الجديد أن نحدد أهم الملفات التي يجب أن نحقق فيها إنجازات كببيرة، ونقطع فيها خطوات جادة، مستعين بالله تعالى، متوكلين عليه، موقنين بتوفيقه وعونه، متجردين من حولنا مستمطرين الغوث من الله جل جلاله.
طه سليمان عامر
رئيس هيئة العلماء والدعاة بألمانيا
عضو المكتب التنفيذي للمجلس الأوروبي للأئمة
نقلا عن مدونات الجزيزة بتصرف يسير